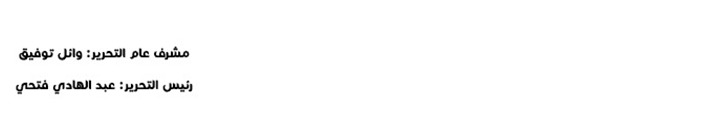العزيمة
العزيمة ..
هل تختلف مصر في العام 1939، تاريخ إنتاج فيلم ” العزيمة “، عن مصر قرب نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين؟! الأعوام الثمانون كفيلة بزلزلة الكثير من الثوابت والملامح الراسخة ذات الطابع الشكلي، الملابس والأدوات المنزلية ووسائل الاتصال، لكن السؤال لا يتعلق بهذا الجانب، وينشغل بالجوهر الذي يشكل إيقاع الحياة الاجتماعية وجملة تفاعلاتها.
“في الحارة”، العنوان الأصلي الذي يُرفض ويتغير إلى الاسم البديل ” العزيمة “، ما يكشف عن جانب مهم في ريادة الفيلم الذي يخرجه كمال سليم “1913-1945″، ويستحق بحق ثناء وإشادة الناقد والمؤرخ السينمائي جورج سادول “1904-1967″،في كتابه “تاريخ السينما في العالم”، حيث يرى الفيلم المصري طليعيًا في التعبير عن الاتجاه الواقعي، ويصنفه واحدًا من الأفلام المئة الأهم في تاريخ السينما.
البطولة في معالجة كمال سليم للحياة الشعبية الحقيقية بلا رتوش، وليس مثل الحارة التقليدية في تجسيد هذا النمط من الحياة، التي تستوعب الطيبين والفقراء، الأغلبية، ولا يغيب عنها الأشرار والأغنياء، الأقلية.
عبر هذا المزيج تتشكل لوحة صادقة موجعة، تتجاوز المحاكاة الشكلية الميكانيكية للواقع، وتحيط بالمفردات التي لا ينبغي تجاهلها: نداءات الباعة، ثرثرة القهوة، حركة الدكاكين متنوعة الأنشطة، الموالد والليالي الرمضانية، الإشارات التي تستعرض هموم الواقع اليومي دون تورط في مستنقع الخطابية الفجة الزاعقة.
لا وجود لحارة الفيلم القديم في الحياة المصرية المعاصرة، ولا يعني هذا تطورًا أو تقدمًا. العشوائيات طاغية الوجود، وأكوام القمامة الهائلة، التي تغيب عن الفيلم، تحتل الصدارة الآن وتصنع القبح المنفر الذي لا شبيه له. لم يكن الأمر على هذا النحو المقزز في مصر الثلاثينيات، ذلك: “العهد البائد” الذي تشتعل لإصلاحه وتغيير مساره ثورات وثورات، وإذا بالأغلب الأعم من المصريين المعاصرين يسكنهم الحنين إلى ما كان واندثر، ويحلمون بالحد الأدنى من سمات القديم المنقرض: الهدوء والنظافة واللغة الأقرب إلى التهذيب.
**
أزمة البطالة طاحنة في ثلاثينيات القرن العشرين، وليس أدل على ذلك من أن حاملي الشهادات العليا لا يجدون وظيفة. يتضمن الفيلم عناوين صحفية لافتة، لعل أبرزها وأكثرها دلالة: “500 من جملة الشهادات العليا يتقدمون لوظيفة محصل بأربعة جنيهات”!
ثمة عنوان كارثي آخر: “يطلق الرصاص على زوجته وولده ثم ينتحر يأسًا من إيجاد عمل”، ولا تكتمل اللوحة القائمة بمعزل عن وجود الاتجاه المضاد الذي يشير إليه عنوان صحفي مثير، حول إنفاق آلاف الجنيهات على راقصة!
هكذا كانت مصر في الثلاثينيات: فقراء يعانون وصراع طبقي محتدم ينذر بكارثة وانفجار يطيح بكل شيء، فهل هى أفضل حالاً بعد عشرات السنين؟. الإجابة بالنفي، والخمسمائة الذين يتصارعون للحصول على وظيفة محصل هم الآن آلاف وآلاف، وما أكثر الذين يقتلون أبناهم وزوجاتهم ثم ينتحرون، وتُنشر أخبارهم في صفحات الحوادث بلا اهتمام، ذلك أن الظاهرة عادية يومية مألوفة لا تثير الدهشة.
التغيير إلى الأسوأ، والكوارث القديمة تتفاقم، ولا مهرب عندئذ من الاستعانة بالمثل الشعبي الحكيم: “لا تعايرني ولا أعايرك.. الهم طايلني وطايلك”!.
**
الطيبون في الزمن القديم، وما أكثرهم، يتفاعلون مع منغصات الحياة ببساطة أخاذة سلسة، ولا يحملون للدنيا همًا. الحاج روحي الحانوتي، مختار عثمان، يعبر بكلماته ومواقفه عن قطاع عريض من المصريين الشعبيين الذين يعيشون يومًا بيوم، وربما ساعة بساعة، وشعارهم الأثير: “خليها على الله”.
الرجل ذو المهنة سيئة السمعة، لا يرى في الموت شبحًا يعكر صفو الحياة، بل إنه قد يكون أداة إيجابية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في مواجهة التحديات والأزمات. الأسطى حنفي، عمر وصفي، محاصر بالديون الثقيلة المتراكمة، وأدوات دكان الحلاقة، مصدر رزقه الوحيد، معروضة للبيع في المزاد. الابن محمد، حسين صدقي، عاطل مأزوم عاجز عن إنقاذ أبيه، وفي حوار الشاب المتعلم مع الحانوتي يبدو الموت أملاً وحيدًا للنجاة:
– هو المزاد الساعة كام بكره؟
– الساعة عشرة.
– يحلها ألف حلال.. أنا عندي زبون سُقع.. واحد بيه قد الدنيا.. إذا كان ربنا يفرجها وياخد أجله من هنا للصبح.. أقبضك يا عم تدفع المتأخر وتحوش البيع وتبقى الأشيا معدن.
– الله يجازيك يا حاج روحي.. بقى عشان نفك ضيقتنا نموت لنا واحد.
– نموت لنا؟ أستغفر الله العظيم .. أنت هاتكفر يا سي محمد ولا إيه؟ احنا هانخنقه يا أخي .. دا شغل عزرائيل”.
الموت جزء أصيل من نسيج الحياة، والاستعاذة بالله من الكفر لا تتعارض مع السخرية من عزرائيل. لا ذرة من التنطع وادعاء الورع الكاذب المصنوع، والتعايش بين الدين والدنيا يخلو من النشاز والصدام. يستسلم محمد بلا حيلة، ويرضخ يائسًا للشروع في إجراءات البيع، وعندئذ تلوح مقدمة الجنازة بإيقاعها الموسيقي المميز، ثم يهرول الحانوتي الطيب بالخلاص الذي لا سبيل إليه إلا بالموت، لتستمر الحياة.
**
المعلم العتر الجزار، عبدالعزيز خليل بحضوره الطاغي المتوهج، سيد الحارة على الصعيد الاقتصادي، وبفضل ثرائه غير المحدود يرى نفسه الحاكم المسيطر الأحق بجميلة الجميلات فاطمة، فاطمة رشدي. لاشك أنه يشتهيها ويرغب في اقتنائها، ولاشك أيضًا أنه يضيق بمنافسه وغريمه محمد أفندي.
لمن الغلبة في الصراع متعدد الوجوه بين محمد والعتر: المتعلم الذي يكابد الفقر والبطالة، أم الجاهل المسلح بالثراء وما يترتب عليه من القوة والنفوذ؟. في كلمات الجزار الشرس ما يحدد رؤيته لطبيعة المنافسة غير المتكافئة، ويقينه الراسخ بلا جدوى أن تكون متعلمًا أو مثقفًا. يقول لشيخ من مجالسيه: “أنا عقليِ بيقولي أجيب لي واد كاتب هنا في الدكان عشان الحاجات اللى زى دى.. حكم أنا ما علمونيش وأنا صغير عشان كنت حيلة.. القراية والكتابة دي حكاية فنطزية”.
إنه يستعين بمحمد لقراءة الإخطار الحكومي، وبعدها يستعرض متغطرسًا للتعبير عن الاستهانة بمكانة المتعلمين. الأغنياء من أمثاله قادرون على شراء الأفندية وتسخيرهم بالثمن البخس، وقادرون أيضًا على إهانتهم وسلب حبيباتهم والتفنن في إذلالهم. قد ينتصر محمد بشكل مؤقت، ويظفر بالوظيفة والزواج من حبيبته، لكن عودته إلى ساحة البطالة تتيح للجزار أن يستعيد ما ضاع. حافظته منتفخة، وقدرته الشرائية لا تبارى، ليس شراء الحصان أو السيارة فحسب، بل شراء البشر أيضًا.
الخلل الطبقي لا يتوارى بسقوط العهد الملكي وميلاد الجمهورية وشيوع الشعارات الاشتراكية، ومصر المعاصرة لا تختلف عما كان، بل إن الصراع الطبقي أكثر حدة وشراسة. حملة الشهادات الجامعية وما بعدها، الماجستير والدكتوراه، لا يجدون عملاً، والأغلبية من أصحاب المليارات والملايين لاحظ لهم يُذكر من العلم والثقافة، وهم امتداد المعلم العتر مع اختلاف شكلي غير مؤثر في أنشطة العمل والنمط الاستعراضي الذي يمارسونه.
**
تكشف قصة الحب بين محمد وفاطمة عن الحالة العاطفية المصرية في الثلاثينيات، وفي اللقاءات التي تجمعهما قبل الزواج، في “بير السلم” و”السطوح”، مزيج من الحياء ومراودة الجسارة والاقتراب من الحلم الذي لم تكتمل أبعاده بعد، حلم الانطلاق والتحرر والاندماج في منظومة قيم عصرية، لا ترى الحب خطأ أو خطيئة.
تتحمس الفتاة الشعبية للزواج وليد الحب، لكنها لا تتخلى عن التشبث بالمظاهر والطقوس الاجتماعية. سقوط محمد من جنة الأفندية إلى هاوية العمل الدوني المتواضع، كفيل بزلزلة الاستقرار والوصول سريعًا إلى الطلاق. إنها مرحلة انتقالية، تتبلور ملامحها في العقود التالية فتستقيم المعادلة، ثم يبدأ طوفان التراجع ويرتد المجتمع المصري إلى ما قبل الثلاثينيات. بالنظر إلى ملابس فاطمة، التي لا تعرف الحجاب ومظاهر التدين الشكلي، لابد من التسليم بالردة الحضارية، والتأكيد على أن عملية التطور الاجتماعي لا يمكن أن تكون فعلاً ميكانيكيًا.
**
شريحة لا يُستهان بها من شباب الأرستقراطية المصرية، ماسخون مستهترون فاسدون مدللون، كما يقدمهم الفيلم. لا شيء ينشغلون به إلا اللهو والعبث والعربدة، فضلاً عن الولع بالسخرية اللاذعة من الفقراء الجادين المقبلين على العمل والبحث عن معنى.
عدلي، أنور وجدي، ابن نزيه باشا، زكي رستم، يعبر وأصدقاؤه المقربون، عبد السلام النابلسي وشلته، عن التوجه السلبي الجدير بالهجوم الذي يشنه الفيلم ليدينهم ويشهّر بهم ويكشف في قسوة عن مثالبهم، لكن الموقف الذي يتخذه كمال سليم ليس مطلقًا أحاديًا متشنجًا. الباشا وقور محترم مبرأ من آفة التعالي، والابن اللاهي نفسه لا يستمر طويلاً في درب السقوط الأخلاقي. سرعان ما يفيق ويتعلم القيم الإيجابية، بل إنه يلعب دور الناصح الأمين الحكيم لصديقه محمد، عندما يبالغ في الجفاء مع طليقته ويرفض أن يعيدها إلى عصمته على الرغم من ندمها واعتذارها.
الرؤية متوازنة لا ترى في الواقعية هجاء حادًا مستمرًا للأغنياء، ولا يملك المنصف الموضوعي إلا أن يرى فى الأوضاع المصرية المعاصرة تدهورًا يفوق ما كان. الأمر، في جانب مهم منه، يتعلق بالإنسان الذي يجمع في أعماقه بين الخير والشر، وتحركه دوافع ذاتية تشتبك مع العوامل الموضوعية. التعميم الإنشائي ليس عادلاً بطبيعة الحال، لكن الخلل يتضخم، وبذخ الأثرياء في الإنفاق السفيه يتضاعف، وازدراء الفقراء والتعالي عليهم شائع ويمثل موضوعًا مكررًا مألوفًا في وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة، فضلاً عن معطيات الشارع التي لا تكذب.
**
حسين صدقي، في أهم وأشهر أدواره السينمائية، يمثل في اعتدال متوازن يتراجع في أفلامه التالية، أما فاطمة رشدي فهي ممثلة مسرحية في المقام الأول ولا تستطيع الإفلات من تراثها الذي يشكل نجوميتها.
قد لا يكون زكي رستم في أفضل حالاته، بفعل محدودية الدور ومساحته التي لا تتيح الانطلاق، وكذلك الأمر بالنسبة لأنور وجدي وماري منيب، لكن نجوم الظل العباقرة، مختار عثمان وعبدالعزيز خليل وحسن كامل وعمر وصفي، هم الملمح الجميل الذي يمنح المذاق الفريد. يجذبون الأنظار في المشاهد التي يسيطرون على إيقاعها بالعفوية والصدق والبساطة، ولا معنى هنا للبحث عن الموقع الذي تحتله أسماؤهم في أفيشات الدعاية، وستبقى هذه الظاهرة ملازمة لجملة الإنتاج السينمائي المصري عبر مراحله المختلفة: أسماء محدودة الموهبة تتصدر وتحصل على الأجر الأعلى والشهرة المدوية، وأساتذة في الأداء المتوهج يحتفظ المشاهد بوجوههم دون أسمائهم!
**
“العزيمة” فيلم معاصر في عيون من يولدون بعد نصف قرن وأكثر من عرضه الأول، ولا يشعر هؤلاء المتلقون الجدد بالغربة والغرابة في حضرته. يجدون فيه بالضرورة وثيقة تاريخية وشهادة على زمن قديم، الأزياء والمعمار واللغة والعادات والتقاليد، لكنه وثيق الصلة أيضًا بالحاضر الذي يعيشه المصريون بعد ثمانين عامًا من إنتاجه. الأمر لا يتعلق بالبراعة الفنية والصدق فحسب، بل إنه نابع أيضًا من حقيقة إن إيقاع الحياة المصرية لم يتغير كثيرًا، وجملة الأمراض والعلل الاجتماعية على حالها، أو ربما هي أشد سوءً!.