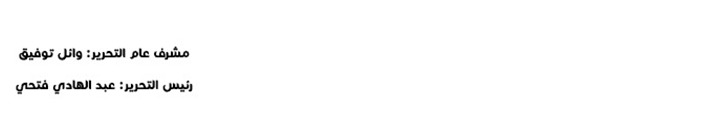اللعبة الأخيرة – الجزء الأول

اللعبة الأخيرة – الجزء الأول «اجلسي, أرجو أن ترتاحي قليلًا ولا تفكِّري في شيء الآن.. كوب الليمون مع النعناع سيكون مهدئًا مناسبًا لكِ.. ثوانٍ وسأعود»، تركتُها وحيدة مرتبكة, تبدو في أواخر العشرينات, عيناها زائغتان, هناك شيء يُخيفها, هناك ندبة حديثة بجوار عينها اليسرى, نتيجة ضربة قوية, لكمة, لا.. لا.. ليست لكمة عشوائية أو اصطدامًا بجدار أو عمود مثلًا, إنها بالتأكيد لكمة شديدة القسوة جاءت مباغتة إن صح ظني, أنت تدرك جيدًا أنني في عام 1975 فتحت عيادةً للأمراض النفسية, لقد شعرتُ بالإرهاق الشديد من كثرة السفر، لكنني أيضًا لا أطيق الجلوس بلا عمل, بلا حالات مرضية نفسية تشغل تفكيري, بلا ظاهرة غامضة تؤجِّج عقلي المزدحم بالكثير من الأمور والأفكار التي لو اطلع عليها الكون لارتبك.
ليست جميلة أيضًا، لكنها عادية, تلك الكلمة الدارجة التي نستخدمها حينما لا نستطيع وصف شيء ما, لكنني لا أقصد ذلك المعنى, بل أقصد أنها عادية حدَّ الريبة, تبدو لي أكثر مما يظن عقلي؛ لذلك كان عليَّ الخروج لأتابعها من ذلك الثقب الموجود في الحائط الفاصل بين غرفة الكشف والمطبخ, لا أحد يستطيع كشفه لأنه ببساطة يقع بين الكتب من الاتجاه المقابل؛ حيث صممته بالشكل الذي أستطيع به ملاحظة كل ما يجري في الغرفة دون أن يكتشفه أو يلاحظني أحد, أرجوك لا تفهمني خطأ؛ فأنا رجل يعتبر النساء ندبة على وجه الكرة الأرضية, ندبة بشعة يستحيل التخلُّص منها وبطبيعة الحال أنا متشكك للغاية في كل شيء.
في الحقيقة، إنها ساكنة للغاية, تتلفَّت حولها من آنٍ لآخر بشكل منتظم وكأنها، دون أن تلاحظ، اكتسبت عادةً جديدة، كما تبدو لو أنها تخشى شيئًا خفيًّا لا يراه سواها, دلفت الغرفة سريعًا ومعي عصير الليمون بالنعناع, لا أعرف كيف يشربه هؤلاء حقًّا! إنه بشع, تناولَتْه مني بأدب وبعينَي قطة خائفة مرتابة تخشى هجومًا مفاجئًا, مسحتُ نظارتي الطبية جيدًا وجلستُ في مواجهتها على كرسي مريح، بينما جلسَتْ هي على أريكة عريضة في مواجهتي وفي يدها عصير الليمون بالنعناع الذي لم يُمسّ حتى هذه اللحظة, انتظرت طويلًا وأنا أنظر لها نظرة محايدة, في الحقيقة لم أخمّن فيمَ تفكر، لكنها كانت شاردة بعيدًا, بعيدًا جدًّا للدرجة التي جعلتها تنسى وجودي من الأساس.
«أنا خائفة».. تلك كانت جملتها الأولى في الحقيقة – منذ جاءت مترددةً إلى بابي – التي قطعت الصمت كسكين في صدرٍ لم يتهيَّأ للضربة بعد.
«ممَّ تخافين؟!». قلت بهدوء ونبرة تشجيعية.
رفعَتِ الكوب بيد مرتعشة وشفتين مرتجفتين مفكرةً أو كأنها تتهرَّب من السؤال ثم رشفت منه قليلًا ثم قالت: «منه».
«ومن يكون هذا الذي تخشينه؟!».
«إنه يأتي ليلًا».. قالت وهي تنظر عبر النافذة المغلفة والمغطاة بالستائر القاتمة.
«ولِمَ تسمحين له بالدخول إن كنتِ تخشينه؟!». قلت بنبرة محايدة لا يشوبها شيء من العتاب أو التأنيب .
فتطلعت لي لوهلة, بدت كشخص أوشك أن يلقي بنفسه من فوق جرف ثم قالت: «لأني لا أستطيع منعه, إنه زوجي».
«ولماذا تخشين زوجك؟!».
«لأنه… لأنه…». لم تتكلم, أشاحت بوجهها بعيدًا, سقطت دموعها, الضعف يؤلمها والاعتراف يؤلمها أكثر, كما أن الخوف الساكن فيها احتلَّها بشكل كبير والخوف أن يكون قد احتلها تمامًا.
«تكلمي, لا تخافي يا لينا». نعم ألم أقُل لك؟! اسمها لينا عماد، تقطن بالعجوزة, تعمل مُدرِّسة رياضيات للمرحلة الإعدادية, في الحقيقة هذا كل ما أعرفه, فلست ضابط شرطة أو منجِّمًا, ناولتها منديلًا بهدوء ثم نهضت من مكاني كي أفضي لها مساحة تكفكف فيها دموعها وتستعيد رباطة جأشها, جلستُ خلف مكتبي أقلِّب في بعض الأوراق عبثًا, أرمقها بطرف عيني من وقت لآخر, طلبت مني كوبًا من الماء, نظرت على دورق المياه لكني وجدته فارغًا فأخذته وانطلقت صوب الثلاجة في المطبخ، لكني سمعت باب شقتي يُفتح ويُغلق سريعًا, تسمرت مكاني وأخذت نفسًا طويلًا شاعرًا بالحزن, لقد غادرت..
غادرت تمامًا.
* * *
مرَّت الأيام القليلة اللاحقة تباعًا وأنا منحسر بين القراءة ومتابعة بعض المرضى القليلين الذين زاروني خلال المدة السابقة؛ فقد كان اللجوء إلى الطبيب النفسي في تلك الحقبة يُعد معجزة في حد ذاته, أنت تدرك جيدًا أن الأمور في مصر تسير على شاكلة معينة ودقيقة وكأنها عُرْفٌ, فمن يصيبه مرض نفسي يعتبرونه ممسوسًا من الجان الضعفاء المساكين أو مجنونًا منتهيًا أمره, فذلك سيكون أهون كثيرًا, ودعك من نظرية أن العلم يتفوَّق على الخزعبلات؛ لأن الأخيرة تلك تحديدًا هي ما نسير على نهجها المتوارث المقدس في الأمم العربية, لن أطيل عليك الحديث؛ فقد لفت انتباهي خبرٌ في جريدة الأهرام، في صفحة الحوادث تحديدًا؛ حيث وجدت أن هناك جريمة سرقة وقعت في أحد محال المجوهرات الشهيرة, ذلك أمر عادي، لكن الغريب في الأمر أن السرقة تمت عن طريق سيدة ملثَّمة كانت ترتجف من شدة الخوف وهي تحمل سلاحًا في يدها مهددةً صاحب المحل بملء الحقيبة الكبيرة التي تحملها بالمجوهرات، وحينما حاول الجواهرجي مواجهتها في اللحظة التي أحس بتملك الخوف منها أطلقت عليه رصاصة، لكن الحمد لله لم تقتله, فقد شاء القدر أن تصيبه في كتفه، وهذا ما يعكس خوفها، وقد أدلى شهود العيان بشهادتهم؛ حيث رأوا سيارة من نوع «بيجو» تقف وتلقفها سريعًا ثم تختفي عن الأنظار.
أقرأُ الكثير من الأخبار كل يوم تقريبًا لعل شيئًا يحرِّك تفكيري، ولا أعرف تحديدًا لِمَ أثارتني تلك السرقة بالذات, عرفتُ أن المسؤول عن القضية هو صديقي الطيب بدر السيوفي، رئيس مباحث العاصمة، إن كنت تتذكره, ذهبتُ إليه في القسم واستقبلني استقبالًا حافلًا ولعنني كعادته على سبيل مداعبتي, لا تنسَ أنه ضابط شرطة !, سألته عن حاله وعن أولاده، وبدا أن كل شيء يسير على ما يُرام, نظر في عيني وأنا أحتسي قهوتي السادة معه ثم قال بنبرته العميقة وتلوح على وجهه ابتسامة أعرفها جيدًا: «كمال.. أنت هنا من أجل العمل وليس من أجل رؤيتي، أليس كذلك؟!».
ابتسمت وقلت بلا كذب: «بل من أجل الاثنين».
فقهقه قائلًا: «لعنة الله عليك يا أخي, ملعون ذلك العمل الذي يبعدك عن كل من يحاول الاقتراب منك, أصحاب العقول في راحة».
فابتسمتُ قائلًا: «لا أعتقد أنهم في راحة».
فضحك وقال بنبرة جادة بعض الشيء: «ماذا تريد؟! أنت تعرف أني لن أتأخر عنك في أي خدمة تطلبها».
فكرتُ قليلًا وأنا أحسبُ كلماتي ثم قلت وأنا أضع فنجان القهوة على الصينية الموضوعة أمامي على منضدة صغيرة مواجهة لمكتبه: «أنا مهتم بجريمة سرقة الجواهرجي الشهير».
تطلع إليَّ قليلًا ثم قال: «أتعرف عنها أي تفاصيل؟!».
فقلت: «ليس أكثر مما ذُكر في الجريدة».
أومأ برأسه مستجيبًا ثم قال: «على العموم، إنها ليست أول سرقة تقع بهذه الطريقة، لكننا عتَّمنا على الموضوع إعلاميًّا, منعنا أي جريدة من النشر في هذا الموضوع, في الحقيقة يا صديقي, إن الجرائد لا تكتب عن كل الجرائم التي تحدث، لكن الأكيد أنها لا تنشر ما نطلب نحن التعتيم عليه».
فقلت مستغربًا: «ولماذا طلبتم التعتيم على قضية كهذه؟! ولِمَ قمتم بكشف الستار عنها الآن؟! ما الذي دفعكم إلى تبديل الرأي؟!».
فقال مبتسمًا: «أنت كما أنت.. كمال الذي لن يتغيَّر, عمومًا أعطني دقيقة واحدة». نهض من مجلسه خلف المكتب ثم وقف خلف الباب ونادى على العسكري الواقف في الخارج وهمس له بشيءٍ ما لم أتبيَّنْه ثم عاد إلى مجلسه وقال: «لقد وقعت الكثير من السرقات خلال الأشهر الستة الأخيرة في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية, القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والقليوبية وغيرها من الأماكن، وكلها تتم بطرق غريبة نوعًا ما, جميعها تمت تحت تهديد السلاح, سرقات بالإكراه…».
قاطعنا صوتُ قرع الباب فأمره «السيوفي» بالدخول, دلف ضابط صغير السن وفي يده ملف, حيَّا «السيوفي» وأعطاه الملف ثم سرعان ما صرفه الأخير بعد أن شكر له طيب صنعه, فتح الملف بهدوء ثم قال: «كما هو موضَّح أمامي وكما أخبرتك, الجناة هنا امرأة ورجل دائمًا ما يجلس خلف مقود سيارة, لم يرَهُ أحدٌ أبدًا أو يتعرَّف إليه, كما أن السيارة تتبدَّل في كل عملية سرقة ولم يستطِع أحدٌ أن يدلنا على أيِّ رقمٍ من أرقام تلك السيارات؛ لأنه في كل مرة يدلي أحدهم برقم نصل إلى طريق مسدود، والمرة الوحيدة التي استطعنا أن نستدلَّ على إحداها وجدناها محطَّمة تمامًا بجانب إحدى البنايات القديمة بالمهندسين, غريب! أليس كذلك؟!».
نظرت له نظرةً محايدةً وأنا أفكِّر فاسترسل قائلًا: «لكن الغريب حقًّا أن كل الذين تعرضوا للسرقة أجزموا بأن المرأة التي تسرقهم تكاد يقتلعها الخوف، لكنها لا تتوانى عن إطلاق النار إن حاول أحدهم منعها من إتمام السرقة. والغريب أيضًا أن الرصاص الذي أطلقته مرتين كان تحت تأثير الضغط كما نعتقد حتى الآن، وحسب المعطيات التي نحن بصددها, مرة أثبت الطب الشرعي أنها خرجت بشكل مباشر، تلك التي قرأت عنها في الصحف، أما المرة الثانية فقد أصابت الرصاصة المجني عليه من الجانب، أي أن الرصاصة أطلقها شخصٌ آخر من مسافة ليست بعيدة أيضًا بالمناسبة, بالطبع أنت تفهم أن شريكها، أيًّا ما كان جنسه، هو مَن قام بإطلاق النار؛ حيث أدلى المجني عليه بأقواله قائلًا إنه كان على وشك القبض عليها لولا تلك الرصاصة التي باغتته والحمد لله أنه لم يمُت».
فكرتُ قليلًا وتطلعتُ إليه لوهلة ثم تساءلتُ: «هل هناك أي شيء آخر ينبغي أن أعرفه؟! بالتأكيد هناك المزيد يا بدر».
قهقه «بدر» كعادته ثم قال: «بالتأكيد هناك المزيد؛ فقد أكَّد لنا أكثر من شاهد عيان أن الجانية لا تستخدم كلمات كثيرة حين اقتحام أي محل، لكنها تستخدم كلمات غريبة, كلمات لن يستخدمها سارق يحمل مسدسًا في يده كما تعوَّدنا وكما نرى عمومًا في الحياة, كلمات على شاكلة: أرجوك، ضع المجوهرات هنا.. أرجوك، لا تتحرك.. أرجوك، لا أريد أن أقتلك. حتى إن الجواهرجي الأخير تعاطف معها كثيرًا, فحينما دلفت عليه تطلَّع إليها مستغربًا, فقد أقسم إنها كانت تبكي وهي تقول: أرجوك، نفِّذ ما أطلبه سريعًا؛ فلقد تعبتُ من كل هذا الهراء. وحينما حاول الاقتراب منها أصابه الطلق الناري, وقد أكدت السيدة الشاهدة على الحادث أنها هرعت تجاهه ونظرت له وهي تقول بنبرة معاتبة: ألم أقل لك إني تعبت؟! لماذا فعلت ذلك؟! أنت الذي دفعتني, أنا لم أفعل شيئًا. الغريب أنها بدت منهارة تمامًا يا صديقي».
أومأتُ برأسي ثم قلت: «لماذا لم تنشروا عن الأمر منذ بدايته؟!».
قال بنبرة جادة عميقة: «تلك كانت تعليمات الإدارة؛ فقد رأوا أن يعطوا للجناة مساحةً من الأمان كي يطمئنُّوا أن الشرطة لا تعرف شيئًا عن الموضوع فتتلاعب برأسهم الأفكار ويتملَّك منهم الجشع حال كلِّ من يشبههم فيُقدموا على سرقات أخرى؛ حيث قمنا بنشر قوات أمن قريبة من كل الأماكن المحتمل السطو عليها، ولكن كما تعلم نحن لا نستطيع تأمين كل شيء، كما أن الإدارة رأت أن النشر سيعمل على نشر الخوف بين المواطنين؛ فنحن لسنا أمريكا التي لديها عصابات مسلحة منتشرة في كل مكان, نحن أناس طيبون مسالمون أبعد ما يكون عن المشكلات يا كمال, أليس كذلك؟!».
ضحكتُ رغمًا عني ثم قلت: «بالطبع، ولكن ما الذي غيَّر رأيَكم الآن؟!».
فقال: «لأن الموضوع أصبح ماسخًا، وقد عرفه الكثيرون، وقد انتشر الأمر في البلاد التي وقعت فيها السرقات وكثرت الإشاعات حول الأمر, فقررت الإدارة النشر حتى يتسنَّى للجميع معرفة الأمر وكشف الستار عن حقيقة الإشاعات المنتشرة, ربما وجدنا بينهم مَن يساعدنا على الاستدلال عليهم». رمقني بنظرة مشاغبة شقية؛ حيث لمعت عيناه الضاحكتان ثم قال: «لديَّ مفاجأة لك».
فقلت مستغربًا: «مفاجأة؟!».
فتح درج مكتبه وأخرج صورة ثم ناولها إياي ثم قال: «هذه صورة جيدة للسارقة, كان هناك مصور فوتوغرافيا, ضمن هؤلاء المتسكعين الذين يسيرون في الشوارع ويصوِّرون كل شيء, لحسن الحظ أنه كان قريبًا من مكان الحادث واستطاع أن يلتقط تلك الصورة, ربما لا تظهر فيها ملامحها بشكل كامل نظرًا لأنها ملثمة، ولكن كما ترى يمكننا رؤية شريكها السائق من جانب وجهه».
تطلعتُ إلى الصورة متأملًا, تبدو الجانية في وضعية هرب وفي يدها حقيبة سوداء متوسطة الحجم بينما يبدو السائق… يبدو… غريب! نعم غريب جدًّا! يبدو أنه بان على ملامحي ما أثارني فقال «السيوفي» مستفسِرًا: «لونك تغيَّر, ماذا هناك؟!».
هززت رأسي ثم قلت وأنا أناوله الصورة: «لا شيء».
نظر إلى الصورة طويلًا ثم قال ضاحكًا بينما كنت أنا أسبح في عالم آخر: «أتعرف يا كمال أن ذلك الرجل يشبهك من ذلك الجانب الذي يظهر فيه وجهه؟!».
* * *
لم أنَمْ طوال الليل وأنا أفكِّر في كل الأمور المتعلقة بتلك القضية, لا أعرف لِمَ استحوذت عليَّ تلك القضية إلى هذه الدرجة، وبالطبع ربط الجانية بالحالة نفسها التي زارتني منذ أيام, أقصد لينا عماد، التي هربت قبل أن تصرِّح بما يعتمل في نفسها, تُرى ما الذي دفعها إلى اللجوء إليَّ؟! وما الحقيقة خلف تلك المرأة؟!
تسلَّمتُ جريدة الصباح كما هي العادة وبحثت داخل الأخبار لعلِّي أجد شيئًا، ولدهشتي وجدت الصورة الملتقطة للحادث الأخير، التي رأيتها بالأمس لدى «السيوفي»، منشورةً مع خبر في الجريدة يفيد باقتراب التوصُّل إلى الجناة, تأملتُ الصورة المنشورة قليلًا ورغمًا عني لم أنفك عن التفكير في لينا عماد, فاجأتني دقات الباب الصباحية.. إن موعد العيادة لن يبدأ قبل الواحدة ظهرًا, ارتديتُ الروب سريعًا واتجهتُ صوب الباب لأجد لينا عماد تقف في مواجهتي وفي حالة مزرية, تتأملني بعينين ذاهلتين دامعتين, ترتدي جيب أسود قصيرًا جدًّا وبلوزة سوداء مفتوحة عند الصدر, أنت تعرف أن تلك كانت الموضة المنتشرة في السبعينات قبل أن تباغتنا الموضة الغريبة التي تسلكها الفتيات في هذا العصر الغريب في كل شيء, تنحيتُ جانبًا دون سؤال فدلفت سريعًا مهرولة إلى داخل المنزل, تلفَّتت حولها سريعًا وقد بدا في عينيها خوف غريب ثم نظرت لي وبدت كأنها تستعيد وجودها، ودون أن أتفوَّه بكلمة وجدتها تتجه صوب الغرفة المخصصة للكشف على المرضى, تمشي بصعوبة بالغة وكأنها تتألم.
ألم أقُل لك؟! لقد حوَّلتُ نصف شقتي الواسعة إلى عيادة؛ حيث أخذت منها غرفتين كبيرتين، إحداهما خصصتها لاستقبال المرضى والأخرى للكشف عليهم، وفي الحقيقة إنني لم أستعِن بمساعد لعدم حاجتي لمثل هذه النوعيات التي غالبًا ما تستغل المرضى, كما أنني لن أسمح بأن تكون هناك عين أخرى تراقبني طيلة الوقت.
مشيت خلفها والأفكار تحاصرني من كل اتجاه, جلست على الأريكة التي جلست عليها في اللقاء الوحيد الذي جمعنا بينما توقفت عند العتبة لأراقبها، دفنت وجهها بين كفيها ولكنها لم تبكِ, بل بدت كما لو أنها تتحدث أو تدمدم بشيءٍ ما لم أتبينه، وفي اللحظة التي قررتُ فيها الدخول إلى الغرفة سمعتُ طرقات الباب, فنقلتُ بصري متحيرًا بينها وبين الطرقة الطويلة المؤدية إلى بهو الشقة, أصر الطارق على دق الباب مرة أخرى, اتجهتُ صوب الباب مدمدمًا بعد أن أيقنت أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن نتحدث، وهذا كل ما آمله.
فتحتُ الباب فوجدت عامل النظافة يقف في مواجهتي, فصرفته سريعًا قائلًا: لا يوجد لديَّ اليوم ما يستدعي. ودلفت سريعًا إلى الغرفة فوجدت لينا كما هي تدفن وجهها بين كفيها، لكنها أكثر هدوءًا على ما أعتقد, جلست في مواجهتها ثم قلت بهدوء: «كيف حالك اليوم يا لينا؟!».
تطلعت لي بعد وهلة لم تطُل ثم قالت: «لستُ بخير».
«هل هناك شيء تودين أن تخبريني به؟!».
رمقتني بنظرة غريبة بان فيها، لو صح ظني، شيء من الندم المختلط بالألم ولم ترد في النهاية على سؤالي, أخذتُ نفسًا طويلًا ثم قلت: «لقد مشيتِ آخر مرة دون أن نتحدث!».
فقالت بهدوء: «أنا آسفة، لكن كان ينبغي عليَّ ذلك».
اندهشتُ لوهلة من وقع إجابتها الغريبة ثم قلت: «ولِمَ كان عليكِ الانصراف؟!».
فنظرت لي نظرة خاوية تمامًا ثم انهارت باكية دون مقدمات ودفنت وجهها لمرة ثانية بين كفيها.. في الحقيقة، أنا أكره بكاء النساء، ولكن بالتأكيد لا يضايقني بكاء المرضى؛ لأنهم ببساطة مرضى، لكني أيضًا أبقي على مسافة محايدة ولا أدس مشاعري أبدًا في أي موضوع وأعني بكلمة الموضوع هنا «الحالة أو الشخص المريض»، لكني، وللغرابة، تعاطفتُ معها وشعرتُ بأن هناك ثقلًا غريبًا على صدرها تود لو أن تتخلص منه وعليَّ أن أقدِّم لها المساعدة.
نهضتُ من مجلسي وأحضرت منديلًا خاصًّا بي لخلوي من أي مناديل أخرى؛ حيث لم أعمد بعد لشراء المناديل التي كثيرًا ما أستخدمها خلال عملي حينما يبكي المرضى، ثم ناولته إياها فالتقطته بينما أجلس على الكرسي, نظرت لها متأملًا وهي تكفكف دموعها ثم قلت: «لينا.. أيًّا ما كان السبب الذي يغلفك بالصمت فهو نفس السبب للجوئك إلى طبيب مثلي؛ لذلك أنصحك بأن تتحدثي حتى تتخلصي من ذلك العبء على صدرك».
رمقتني بنظرة ممتنة ثم قالت مترددة: «أنت.. أنت رجل طيب ولا تستحق…»، ثم صمتت فجأة وعادت إلى البكاء.
أخذتُ نفسًا عميقًا ثم قلت: «سأحضر لكِ بعض الليمون».
فأمسكتني من يدي بمجرد أن نهضت ثم قالت: «لا داعي, سأنصرف الآن».
شعرتُ بالحزن لأنها ستغادر أيضًا دون أن تتفوَّه بكلمة فقلت لها بنبرة هادئة للغاية: «أتمنى لو أنك تقولين أي شيء, ستشعرين بعدها براحة عظيمة، وتأكدي أني سأكون عونًا لكِ أيًّا ما كانت مشكلتك».
حدجتني بنظرة غريبة شابها شيء من الغضب والحزن معًا ثم قالت:
«لم تعُد مشكلتي بعد الآن».
ثم انصرفت من أمامي وقد شعرتُ بأنها أكثر خفة في مشيتها, متجهة صوب الباب، ولمَّا بلغته استدارت لي ثم قالت بنبرة عميقة: «السفلة كثيرون في هذا العالم يا دكتور كمال, أرجوك اعتنِ بنفسك؛ فأنت رجل طيب ولا تستحق…»، كادت على وشك قول شيء ما، لكنها قطعت كلماتها واكتفت بنظرة خاوية شابها شيء من غياب الوعي.
فتحت الباب في اللحظة التي أربكتني فيها كلماتها فوقفت على عتبة الباب وقلت وهي تغادر: «لينا, سأنتظرك.. لا تتأخري».
في تلك اللحظة، كان عامل النظافة يحمل أكياسًا كثيرة من القمامة نازلا بهدوء درجات السلم, استدارت «لينا» قبل أن تركب الأسانسير ثم قالت بعد تفكير لم يطل: «سآتيك ليلًا».
ابتسمتُ وأومأتُ لها برأسي دون كلمة، بينما توقَّف عامل النظافة يتابع المشهد بأكمله حتى غابت «لينا» داخل الأسانسير واختفت تمامًا, فلمحت عامل النظافة يرمقني بنظرة بلهاء مبتسمًا فرمقته بنظرة غاضبة فهرول منصرفًا من أمامي, أغلقتُ الباب وأنا في حيرة من أمري من كل ما يحدث.
* * *
جلستُ طيلة الليلة أفكر في «لينا» وأربط كل الأحداث ببعضها البعض, انتظرتها طويلًا أنقل بصري من آنٍ لآخر تجاه باب الشقة وأتحفَّز بمجرد سماع خطوات على السلم أو حركة الأسانسير القديم الرتيبة، ويبدو أني غفوت على الأريكة.
صباح يوم الاثنين، وهو اليوم التالي، وقعت سرقة أخرى لمحل جواهرجي بحي الحسين، لكن هذه المرة كانت هناك دماء كثيرة؛ فقد أُردي الجواهرجي صاحب المحل قتيلًا إثر تلقيه طلقًا ناريًّا في صدره، بينما أصيبت إحدى شهود العيان بطلق ناري في الجزء العلوي من صدرها وقد نُقلت إلى المستشفى في حالة خَطِرة, وقد اتجهت الشرطة صوب المكان بقيادة السيوفي للقيام بمهامها وقد عرفت من خلال جريدة الثلاثاء أن شهود العيان الذين حضروا الواقعة أجزموا جميعًا بأن الجاني سيدة ترتدي عباءة سوداء وملثمة، وهي المواصفات نفسها التي تتطابق مع السيدة المنشورة صورتها في الجريدة سابقًا.
جلستُ على كرسي وثير أحتسي قهوتي مفكرًا في كل ما يحدث، وفي الحقيقة كنت مستاءً؛ لأن «لينا» لم تأتِ ولم أسمع عنها أي أخبار حتى الآن, فجأة انتبهتُ لشيء مهم وهو أنني أعرف اسمها وعنوان سكنها، أو على الأقل المنطقة التي تقيم فيها, اتصلتُ سريعًا بصديقي بدر السيوفي وزوَّدته بالمعلومات التي لم تكُن كافية بالتأكيد، لكنه وعدني بأنه سيبذل قصارى جهده، كما أنه أخبرني أنه يريد رؤيتي في اليوم نفسه لحاجته الملحة لاستشارتي، فوعدته بالزيارة خلال وقت راحتي من العيادة, ربما لم يأتِني أي مريض أو من يشكو علةً في جهازه النفسي خلال الأيام السابقة، لكن في الحقيقة ليس لديَّ أي رغبة في الخروج من المنزل الآن، والحقيقة أيضًا أني لا أعرف السبب، لكن حدسي ينبئني بأن هناك شيئًا على وشك الحدوث, شيء عليَّ انتظاره.
دق جرس الباب بينما كنت جالسًا في مكتبي أقرأ كتابًا دون تركيز, اتجهتُ سريعًا صوبه على أمل أن يكون ذلك الطارق «لينا»، لكني وجدت رجلًا طويلًا, في نفس طويلة تقريبا, تميل بشرته إلى السمرة الرائقة, ذو ملامح شرقية أصيلة, ثلاثينيًّا, وسيمًا بعض الشيء, يرتدي بدلة سوداء وقميصًا أبيض ورابطة عنق زرقاء يقف في مواجهتي وعلى وجهه ابتسامة ثابتة, ظلت عيناي ثابتتين عليه فقال: «أنت دكتور كمال، أليس كذلك؟! هل يمكنني الدخول؟! لقد جئت إليك في أمر مهم, اسمي أحمد أبو المكارم, مهندس مدني، أقطن بالمهندسين». أومأت برأسي دون أن أتكلم؛ حيث كان عقلي شاردًا، ثم تنحيت جانبًا قليلًا لأسمح له بالمرور، وبالفعل دلف الشقة ووقف منتظرًا إشارتي له, تأمل الشقة بشيء من اللامبالاة ثم قدته حتى وصلنا إلى غرفة استقبال المرضى وجلسنا في مواجهة بعضنا, فقال مبتسمًا: «اسمي، كما أخبرتك، أحمد أبو المكارم, أعمل مهندسًا مدنيًّا, متزوج، لكن لم يرزقني الله بأبناء حتى الآن».
قلت وأنا ما زلت أفكِّر في «لينا»: «أهلًا بك سيد أحمد, تُرى ما الموضوع؟!».
فقال كمن يرمي بحجر في بحيرة راكدة: «أنا زوج لينا عماد».
تطلعتُ إليه محاولا بجهد إخفاء آثار المفاجأة وانتبهتُ ثم قلت متلاعبًا: «مَن لينا عماد؟!»، فأنت تعرف يا صديقي أن أسرار المريض لا تخرج أبدًا للغرباء، والغرباء في حالتنا هم أي شخص عدا المريض نفسه.
ابتسم ابتسامة العارف ثم قال: «أنا أعرف يا دكتور أنها تأتي إليك هنا, فأنا في النهاية زوجها ولست غريبًا عنها».
فقلت بشيء من الفظاظة: «وما المطلوب مني؟!».
فقال بهدوء والابتسامة لم تفارق وجهه: «اهدأ يا دكتور, فما جئت هنا إلا لمناقشة حالة زوجتي لا أكثر؛ فأنا لا أملك غيرها في هذه الحياة، وأمرها يهمني أكثر من أي مخلوق آخر على هذه الأرض».
أومأتُ برأسي واستعدت رباطة جأشي ثم قلت: «فنجان قهوة؟!».
فأومأ برأسه مستجيبًا فنهضتُ من مكاني منسحبًا إلى المطبخ وأنا أفكر في الأمر برمته, اعتراني شعور بالضيق وتمنيت لو أنها بخير, لكن حدسي ينبئني أيضًا أنها ليست بخير, فما الذي أتى بزوجها إليَّ؟! وكيف عرف أنها تأتي إليَّ من الأساس؟! يبدو شخصًا عاديًّا لكني لا أشعر بالراحة تجاهه, على أي حال سأعرف كل شيء بعد قليل, وضعت الفنجانين على صينية واتجهت صوبه فوجدته ما زال جالسًا في مكانه يدخن سيجارة بلون بني, سيجارة أجنبية على ما أعتقد, ابتسم ونهض من مكانه على سبيل إظهار الاحترام وتناول الصينية مني قائلًا: «يبدو أنك تعيش وحدك يا دكتور, ألا يوجد من يخدمك؟!»، فهززت رأسي بالنفي دون كلمة, فقال: «لذلك نتزوج, فالزواج أهم شيء في الحياة».
الآن سيبدأ النصح الذي لا جدوى منه, ألا يدرك هذا الأبله أن الزواج هو من قاد المجانين إلينا نحن الأطباء؟! سمعته يقول بهدوء وهو يتناول فنجان قهوته:
«إن لينا، منذ مدة طويلة، تشعر أنها ليست على ما يرام, حاولتُ الترويح عنها بشتى الطرق ولكنها للأسف سقطت في بئر من صمت غريب, لم تعُد تتكلم وتناقش وتتفجر بالحياة كالسابق ولم تعُد الحياة تهمها كما عهدتها، بل أصبحت مهملة لنفسها وحياتها وانزوت بعيدًا عن الناس تمامًا».
فقلتُ وأنا أرشف القهوة: «بالتأكيد هناك سبب لذلك كله».
فقال بنبرة عادية: «دكتور كمال، أنا رجل مشغول تمامًا, طبيعة عملي لا تعطيني مساحة كبيرة من الوقت, أسافر كثيرًا من أجل العمل وأتركها وحيدة بكل أسف, اصطحبتها أكثر من مرة خلال أسفاري الكثيرة، لكن للأسف أنت تعلم أنه لم يكُن لديَّ الوقت الكافي للبقاء معها, كما أننا لم نُرزق بأطفال كما أخبرتك, حاولنا كثيرًا في تلك المسألة لكننا لم نفلح, أنت أكثر الناس إدراكًا أن مسألة الأطفال تلك هي مسألة رزق لا يد لنا فيها؛ لذلك عمدت إلى تشجعيها على العمل، وبالفعل وجدت لها عملًا مناسبًا، ولكن للأسف لم تكمل فيه وانتهى بها الأمر كما أخبرتك».
فقلت مفكرًا: «كيف تزوجتما؟!».
«لقد انتقلت لينا إلى العيش في العمارة التي أقطن بها مع عائلتها منذ خمس سنوات وأعجبت بها وقررت الزواج منها, زواج مصري تقليدي إن كنت تحب أن تطلق عليه وصفًا, لم تكُن هناك قصة حب، بل زواج اتفق فيه الطرفان بعد أن رأيا أنه زواج مناسب لكليهما, لا أكثر, ولكني بالفعل أحببتها بعد الزواج وأعتقد أنها بادلتني الشعور نفسه، لكن مع الوقت حدث ما حدث».
«ومنذ متى تزوجتما؟!».
«منذ سنتين تقريبًا».
أخذتُ نفسًا عميقًا ثم قلت: «ومتى بدأت تلك الحالة؟!».
«منذ ما يقرب من عشرة أشهر، أي بعد الزواج بفترة ليست بالطويلة».
قلت مباشرةً ودون مراعاة لمشاعره: «هل تعتقد أنها ندمت على الزواج منك؟! أو لنقل أنها ندمت على فكرة الزواج نفسها؟! هناك الكثير من الفتيات اللاتي يتسرعن ويأخذن قرارًا سريعًا بشأن عملية الزواج ثم يندمن فيما بعد, والندم له معايير وأشكال مختلفة, هناك من يتمردن ببساطة فيطلبن الطلاق ببساطة، وهناك أيضًا من يعشن في محاولة للتأقلم، وهناك من يصبن بالتغيُّر الغريب، كما في حالة لينا مثلا! ربما كانت هناك علاقة عاطفية قديمة لا تعرف عنها شيئًا!».
وضح على ملامحه الضيق بعض الشيء، لكنه كان قادرًا على التحكم في مشاعره, اكتفى بابتسامة باهتة ورشف القهوة ثم قال بنبرة هادئة: «دكتور، أنا أعرف زوجتي جيدًا، وأقسم لك إنها لم تعرف شخصًا غيري في حياتها، لكني لست هنا من أجل هذا».
رفعت حاجبي منتظرًا أن يكمل كلامه، فسمعته يقول بهدوء: «إن زوجتي حالتها تسوء يومًا بعد الآخر, إنها تخرج وتعود وتكاد لا تتذكر إلى أين ذهبت وكم مضت في الخارج، كما أنها تصحو كل يوم على كوابيس مزعجة فتملأ الدنيا صراخًا, أنا لست من ضمن هؤلاء الذين يعتقدون في الأفكار والأعراف الخاطئة كمس الجان أو ما شابه من هذه الأمور؛ فأنا رجل مثقف ويدرك تمامًا أن زوجته تحتاج إلى طبيب, وطبيب مثلك قادر على علاجها، لكني جئت إلى هنا طلبًا لمساعدتك, كل ما أستطيع قوله إنها قبل أمس كانت مرتعدة ويعتريها حزن عميق.. أخبرتني متلعثمة وبعد تردد طويل، وإلحاح، أنها تشعر أن هناك مَن يلاحقها, لكنها لن تتوانى عن قتله, لم أظفر بشيء آخر أكثر من هذا الاعتراف الغريب الوجل كما ترى, إني منزعج جدًّا منذ تلك الليلة، وقد ترددتُ كثيرًا قبل أن آتيك هنا، لكني أخشى أن يصيبها مكروه، وهذا ما دفعني إليك كي تساعدني, أنا واثق بأنك ستفعل ذلك».
فقلت بهدوء بعد تفكير: «لقد جاءت ووعدتني أنها ستأتي مرة أخرى، لكنها لم تفعل».
ابتسم وقال: «أعتقد أنها ربما تفعل، ومن جانبي سأحثُّها على ذلك, لقد أخذت من وقتك الكثير, لكني على يقين أنك رجل طيب معطاء قبل أن تكون طبيبًا ناجحًا».
سلمت عليه وشكرت له طيب صنعه واهتمامه بزوجته، لكنه استدار قبل أن يغيبه الباب ثم قال وهو ينظر لي نظرة غريبة لم أفهمها: «أتدري يا دكتور؟! وحدهم الأغبياء الذين يظنون أنهم وحدهم الأذكياء». ثم ابتسم بشكل غريب دون أن يلتفت لي مرة أخرى وغادر تمامًا.
أغلقتُ الباب مفكرًا وشاعرًا بالريبة وفكرت بكلمات «لينا» عن زوجها, لقد بدا عليها الهلع منه, لقد قالت إنه يأتي ليلًا ولا تستطيع إبعاده عنها, لم أفهم من كلماتها الكثير ولكن هذا الرجل على الرغم من نيته الطيبة فإنه لا يريحني على الإطلاق..
لا يريحني أبدًا..
* * *
في تلك الليلة، بينما كانت الساعة تدق الثانية عشرة ليلًا، كانت «لينا» تقف في مواجهتي ترمقني بعينين جامدتين غائمتين, تكادان تكونان ميتتين, لم أكُن منزعجًا من المسدس الموجه تجاهي بيدٍ مرتجفة, لم تتفوه بكلمة تهديد واحدة، لكني كنت واثقًا من أن ظلالنا كانت تتخايل على ستائر النافذة المفتوحة, أحسستُ بالمشهد الساخن كاملًا يتسربل ثائرًا داخل دمائي وأحسستُ أيضًا بالكلمات التي تود أن تصرخ بها في وجهي ووجه كل إنسان على هذه الأرض.. في الحقيقة، إنه حينما فتحتُ الباب وجدت الملثمة كما تم تصويرها وكما ظهرت في الجرائد تقف في مواجهتي وتوجِّه مسدسًا في وجهي, ظلت تلكزني في ظهري بالمسدس حتى صرنا على هذا الوضع الذي نحن عليه الآن, مسدس في حالة انتظار تحمله سيدة متهمة بجرائم متعددة, لديها خلل نفسي معروف, تتحكَّم فيها شخصية سادية من خلف الستار, لكن أين ذلك العبقري الشرير؟ وإلى متى سيتأخر؟! أخيرًا.. إني أسمع ضوضاءهم اللعينة, أصواتهم الغجرية, الأوامر الكثيرة المتداخلة التي يصيح بها صاحب الصوت الجهوري, دائمًا متأخرون, دائمًا متأخرون..
«لينا، أرجوكِ.. أنتِ تعرفين أنني لا أنشد شيئًا سوى مساعدتك! لماذا تفعلين ذلك؟!».
«لا تتكلم أرجوك».. صاحت في وجهي بنبرة مهزوزة والمسدس يرتجف في يدها.
«لينا, اسمعيني.. لم يبقَ أمامنا سوى ثوان معدودة قبل أن تقتحم قوات الشرطة منزلي, يمكنني أن أساعدك».. قلت بنبرةٍ مُطَمْئِنَةٍ وبدا في عينيها التردد وهي تنقل بصرها بيني وبين الطرقة.
صرخَتْ في النهاية في وجهي وهي تسدِّد المسدس تجاهي وأكاد أرى إصبعها تتراقص مرتجفة على الزناد: «أرجوك لا تتكلم, لقد سئمت ترهاتك وترهات هذا العالم, يجب أن تموت يا دكتور كمال, لا حيلة لديَّ, يجب أن تموت كي أستريح».
أنهت كلماتها في اللحظة التي اقتحمت فيها قوات الشرطة المنزل وفي مقدمتهم «السيوفي»، الذي دلف الغرفة شاهرًا مسدسه وصائحًا بحزم: «ألقي بمسدسك بعيدًا يا لينا, لم يعد هناك مفر؛ فالقوات تحاصر المنطقة بأكملها, ألقي بمسدسك واستسلمي الآن».
شهقت شهقة مفجعة وشرعت دموعها تتساقط ونظراتها ثابتة عليَّ, نظرات تحمل الألم والخزي ومشوبة بالعصيان والخوف, أحسست أنها لم تسمع «السيوفي» من الأساس, غامت داخل نفسها وغمغمت بشيء لم أتفهمه لكني موقن أنه من نوعية: «لا حيلة لديَّ, عليَّ أن أنفِّذ ما جئت من أجله.. وهو، ببساطة, قتل كمال الشريف».
وانطلقت الرصاصة..
* * *
جلستُ في مواجهة «السيوفي» مطأطأ الرأس, أحسستُ بنظراته مسلَّطة عليَّ كأضواء كاشفة على ملعب كبير خالٍ, كنت أستطيع أن أسمع ما يدور في خلده والتساؤلات الكثيرة التي تناوشه وتكاد تقتلعه, مفكرًا بحذر شديد في أول جملة سيلقيها عليَّ منذ الأحداث الأخيرة.
لقد وجدوا في شقتي مجموعة مجوهرات متناثرة في أكثر من موضع, بالطبع إنها تنتمي للمجوهرات المسروقة من أماكن مختلفة, وخلال اليومين التاليين، وحسب شهادة الشهود، تأكَّد أن «لينا» تتردد على شقتي، كما أكد عامل النظافة أنه رآنا في وضع حميم أمام باب شقتي, لا عجب في ذلك أيضًا! كما أن الصورة المنشورة في الجرائد للسائق تتطابق بنسبة كبيرة معي! شريك الملثمة في عمليات السرقة, كل ذلك لا يهمني، ولكن ما يهمني حقًّا أن تستفيق «لينا» من غيبوبتها؛ فهي لا تستحق الجحيم الذي تعيش فيه.
لقد أطلق «السيوفي» رصاصة عليها قبل أن تجهز عليَّ وقبل لحظة من ضغطها على الزناد, أصابتها الرصاصة في كتفها من الأعلى, كان مشهدًا مؤثرًا وأنا أهرول تجاهها وأرفعها لي قبل أن تبتسم تلك الابتسامة الباهتة والبائسة وتغلق عينيها, تغلقهما تمامًا..
«كيف وقعت في تلك المشكلة يا كمال؟! لا توجد لديَّ حيلة كما ترى, كل الدلائل ضدك».. قال «السيوفي» بنبرة حزينة.
«بدر.. أرجوك.. هل جننت؟! أتصدق ذلك الهراء؟!».. قلت معاتبًا بابتسامة عصبية.
فرمقني بنظرة حائرة ثم قال: «أعرف جيدًا أنك بريء من كل ذلك، ولكن يا كمال أنا رجل شرطة وفي النهاية تتلخص مهمتي في تقديم الجاني إلى العدالة».
«لا تلعب معي لعبة القط والفأر يا بدر.. أرجوك.. ليس هذا وقت المزاح».
ابتسم «السيوفي» بعد وهلة طويلة متلاعبا بأعصابي, فما الضير من التلاعب معي لبعض الوقت, فالسيوفي صاحب مزاج غريب متآصل في المزاح المنحرف ولكنه قال في النهاية:
«ماذا ستفعل إن كانت كل الأدلة ضدك ؟!».
أخذت نفسًا عميقًا شاعرا بالألم, مطأطئًا رأسي ومفكرًا ثم حدجته بنظرة غامضة قائلًا بعد تفكير: