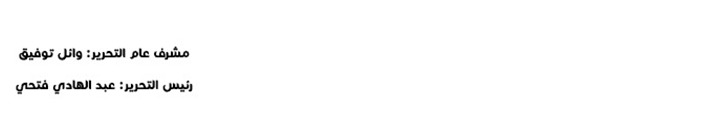عن فيلم الغسالة.. دوران بلا هدف
 أؤمن تمامًا أن الأفلام مثل الأطفال “بتيجي برزقها”.. وأن هناك فترات في عمر السينما كصناعة تنصف أفلامًا لم يتوقع صناعها بالأساس هذا النجاح، لعل أبرزها فيلمي “4-2-4” و”إسماعيلية رايح جاي”؛ فالأول جاء بعد فترة توقف لدور العرض، والثاني جاء بعد ركود في مستوى الكوميديا، وكمرحلة انتقالية بين جيل “الأشاوس” وجيل المضحكين الجدد.. وعلى الرغم من بساطة الفيلمين على مستوى الكتابة والإخراج والتصوير، إلا أن الظروف المحيطة جعلتهما ينجحان في دور العرض، وجعلتهما يعلقان في ذهن المشاهد.. وهو ما حدث مع “الغسالة”.
أؤمن تمامًا أن الأفلام مثل الأطفال “بتيجي برزقها”.. وأن هناك فترات في عمر السينما كصناعة تنصف أفلامًا لم يتوقع صناعها بالأساس هذا النجاح، لعل أبرزها فيلمي “4-2-4” و”إسماعيلية رايح جاي”؛ فالأول جاء بعد فترة توقف لدور العرض، والثاني جاء بعد ركود في مستوى الكوميديا، وكمرحلة انتقالية بين جيل “الأشاوس” وجيل المضحكين الجدد.. وعلى الرغم من بساطة الفيلمين على مستوى الكتابة والإخراج والتصوير، إلا أن الظروف المحيطة جعلتهما ينجحان في دور العرض، وجعلتهما يعلقان في ذهن المشاهد.. وهو ما حدث مع “الغسالة”.
صحيح أن الغسالة – في توقعي – لن يعلق في ذهن المشاهد الخارج لتوه من دور العرض بالأساس، لن يتذكر إيفيه بعينه أو جملة حوارية بعينها، أو حتى لقطة بصرية بارزة.. لكنه نجا من فخ النجاح في شباك التذاكر وحصد ملايين في موسم “ميت” بلغة السينما.. فقد استغل صناع السينما حالة “الركود” ما بعد الكورونا واشتياق الناس لأي شيء من رائحة السينما.. والشعور أن هناك شيئًا من حيواتنا السابقة عادت إلى طبيعتها من جديد.. فنزل الفيلم في ساحة قتال خالية بلا أي منافسين، فطبيعي أن ينتصر.
جوانب أخرى من “رزق الفيلم” هو مشاركة نجم بحجم “محمود حميدة” وبطلي الفيلم “حاتم وهنا” اللذين شكلا ثنائيًا ناجح نسبيًا قياسًا على تجربة فيلم “قصة حب” التي أعجبت شريحة من الجمهور، ولكن الجانب الأهم والأكبر في نجاح “الغسالة” سينمائيًا تمثَّل في الحملة الدعائية للفيلم، والتي تمحورت حول أغنية “دارت الغسالة” للترابر أحمد علي أو “ويجز” الذي حقق بالأغنية نجاحًا سيدوم أطول من نجاح الفيلم نفسه.
(ملحوظة: الفيلم تجربة “جديدة” حتى وإن لم تنل إعجابي بشكل كبير إلا أن جرأة صناعها على طرح الفيلم في هذا الوقت تحسب لهم، وكذلك الغسالة هو تجربة أولى للكثير من طاقم عمله، وكذلك تجربة “جنرة” ليست مكررة ولا مستهلكة في السينما المصرية.. وقد تكون كواليس صناعته تأثرت بالجائحة العالمية.. فشكرًا لهم.)
يروي الفيلم قصة “عُمَر” الذي يعمل معيدًا في كلية العلوم، والذي تخصص في دراسة الفيزياء، ويقع تحت سلطة والده التي جعلته منطويًا يخشى من مصارحة “عايدة” بحبه، ويلجأ للمخدرات مع صديقه الوحيد “سامح”، حتى يكتشف أن غسالة والدته بداخلها آلة للتنقل عبر الأزمنة، ويلتقي بنسختيه المُسنة والطفلة ليعيش الثلاثة معًا مغامرة قصيرة هدفها التأثير على الماضي حتى يظفر “عُمَر” بـ”عايدة”، ويجعلها تبادله شعور الحب.
القصة من بعيد تبدو جيدة، ولكن حين تبدأ الأحداث نكتشف عيبًا كبيرًا في الفيلم، وهو “غياب الثيم”، فالفكرة هنا غير واضحة، فإن كنا نناقش بالأساس قصة حب بين البطل والبطلة؛ فإننا لم نرَ أساسًا لهذه القصة سوى أنه كان “تعلق طفولي”، لم نشاهد عايدة بعيون غير عيون عُمَر، لم نعرف لماذا قد يحبها عمر بالأساس، هي مجرد فتاة جميلة تعمل في قسم العلوم، لماذا لم أحبها كمشاهد وأتعلق بها مثل عمر؟ لا أعرف.
أما وإن كان الفيلم عن فكرة “التنقل عبر الأزمان”، فلماذا تم تناولها بهذه السطحية والسهولة، ولماذا تم ربط الخيال العلمي بالتنفيذ الهزلي للأفكار، مثل مشاهد المعارك الأخيرة، ولماذا ظهرت شخصية عمر وهي محور الأحداث سطحية في نسخها الثلاثة، فلم أعرف شيئًا عن عمر المُسِن، ولا حتى الشاب، هو فقط شاب “وحيد”، لا أكثر ولا أقل.. ولماذا لم يستغرق الفيلم في التمهيد علميًا لحبكة الفيلم، وإظهار محاولات عمر لتنفيذ آلة الزمن، حتى الدراما البسيطة التي كان صنع بها مشهد محوري في الفيلم، مثل حديث النسخة الثلاثينية من عمر عن أمه أمام النسخة الطفلة بصيغة المتوفي، فنظهر أن الزمن قاسيًا في الكثير من الوقت، وتكون لقطة مؤثرة وسط أحداث “خفيفة”، ولكن هذه الفرصة ضاعت كغيرها.
أما وإن كان الأمر مجرد “مثلث حب” بين سامح وعمر وعايدة، فهذا أيضًا ليس موجودًا، فسامح لم يحب عايدة وإنما اشتهاها للحظات قصيرة، حتى زواجه منها في المستقبل كان لمضايقة عمر ليس أكثر، وأيضًا شعرت أن توظيف “سامح” كشرير كان مُقحمًا، فنسختيه الشابة والطفلة لم يظهرا بوادر شر كبيرة، حتى وإن كان سامح الشاب “فهلوي” بعض الشيء، فهذا لا يجعل منه قاتلًا ولا يمهد لتحوله الجذري لزعيم مافيا مخدرات.. علاوةً على أنني لم أشعر بالخوف من سامح كشرير، ولا حتى بقلق من أن تتعلق عايدة به، فأين المشكلة؟
الفيلم في النهاية “محاولة”، في رأيي أنها لم توفق، فبناء الشخصيات راح لصالح جرعة الضحك في الفيلم، وجرعة الضحك تاهت بين الممثلين واعتمدت على قدراتهم الفردية التي لم تكن “في الفورمة، لذلك ظهر الأداء باهتًا لصالح الحبكة الخيالية، والحبكة الخيالية ضاعت وسط صراعات وتطورات غير منطقية، ونهاية تظهر فيها الموعظة واضحةً جلية على طريقة أفلام سراج منير، والأمر الذي كان لينقذ هذه التطورات غير المنطقية هو التأسيس المنطقي للشخصيات، لكنه راح لصالح جرعة الضحك…
نعم هي حلقة مفرغة مثل الغسالة.