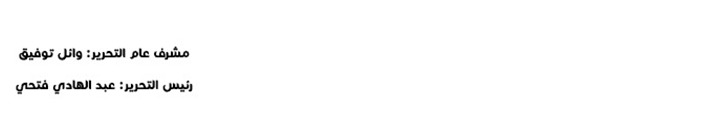كنب: وليد سامي
منزل آل باموق.. عشت أنا وأمي، وأبي، وأخي الأكبر، ووالدة أبي، وأعمامي، وعماتي، في طوابق مختلفة من نفس المنزل المكون من خمسة شقق. حتى قبل مولدي بعام، أقامت الأفرع المختلفة من العائلة (مثل العديد من العائلات العثمانية الكبيرة) معا في قصر حجري كبير. في عام 1951، قاموا بتأجير القصر لمدرسة ابتدائية خاصة وبنوا المبنى الحديث الذي أصبح منزلنا على قطعة الأرض الخالية المجاورة؛ وعلى واجهة المبنى، تماشيا مع التقاليد في ذلك الوقت، وضعوا بتباه لوحة كُتب عليها “منزل باموق”.
أقمنا في الطابق الرابع، لكن كان لي حرية التجول والتنقل في المبنى بأكمله منذ الوقت الذي أصبحت فيه كبيرا بما يكفي لترك حضن أمي. في كل طابق، كان يوجد بيانو واحد على الأقل. عندما أتم أصغر أعمامي الحاصل على البكالوريا استعداداته كي يتزوج، وانتقلت زوجته الجديدة إلى الشقة في الطابق الأول، والتي سوف تقضي نصف القرن التالي تحدق من نافذتها، أحضرت معها البيانو الخاص بها. لم يعزف أحد أبدا على هذا البيانو أو على أيا من آلات البيانو الأخرى.
منزل آل باموق
في كل شقة، كانت توجد حجرة زجاجية صغيرة مُغلقة عُرض بها الخزف الصيني، وفناجين الشاي، والفضيات، وأوعية السكر، وعلب النشوق، والأكواب البلورية، وأباريق ماء الورد، وصحون، ومباخر، والتي لم يمسسها أحد مطلقا، لكن فيما بينها كنت أجد أحيانا أماكن مخفية بها نماذج مصغرة لسيارات. كانت توجد مناضد مطعمة بالصدف غير مستخدمه، وأرفف للقبعات لم يكن عليها أي قبعات، وقواطع يابانية وفن حديث لم يكن مخبأ خلفها شيء. في المكتبة، تجمع الغبار خلف الزجاج حيث كتب عمي الطبية؛ التي لم يمسها أحد طيلة عشرين عاما منذ هاجر إلى أمريكا. وفقا لعقلي الطفولي، فإن هذه الغرف تم تأثيثها للأموات لا للأحياء.
إذا اعتقدت جدتي أننا نجلس بصورة غير لائقة على مقاعدها ذات الخيوط الفضية، كانت تلفت انتباهنا: “اجلسوا معتدلين!”. لم تكن غرف الضيوف أماكن يمكن أن تأمل الجلوس فيها بشكل مريح؛ كانت متاحف صغيرة تم تصميمها للإثبات لزائر افتراضي أن أصحاب المنزل غربيي السمة. قد يعاني الشخص الذي لا يصوم رمضان بتأنيب ضمير بدرجة أقل بين تلك الخزائن الزجاجية وآلات البيانو الميتة، مما كان سيعانيه لو ظل جالسا معقود الساقين في غرفة مليئة بالوسائد والأرائك.
برغم معرفة الجميع أن التغريب كان يعني التحرر من قوانين الإسلام، لم يكن أحد متأكد من أي فوائد أخرى لها. لذا لم تكن بيوت إسطنبول الغنية فقط التي تجد فيها تلك المظاهر العشوائية والقاتمة (لكنها شاعرية أيضا في بعض الأحيان) للتأثير الغربي؛ لقد كانت في جميع أنحاء تركيا. لكن مع قدوم التليفزيون، في السبعينيات، خرجوا عن النمط السائد. فعندما اكتشف الناس مدى المتعة في الجلوس معا لمشاهدة أخبار المساء، تبدلت غرف الجلوس لديهم من متاحف صغيرة إلى دور عرض سينمائي صغيرة، إلا أننا لا زلنا نسمع عن العائلات القديمة التي وضعت أجهزة التليفزيون الخاصة بهم في ردهاتهم الرئيسية، فاتحين غرف الصالون الخاصة بهم في العطلات وللضيوف الغير اعتياديين.
لو سأل أي شخص، كانت جدتي ستقول أنها تؤيد مشروع أتاتورك التغريبي، لكن في الواقع- في هذا كانت مثل البقية في المدينة- لم يكن الشرق ولا الغرب يثيران اهتمامها. في الوقت الحاضر نادرا ما تغادر المنزل، لكنها عندما كانت خطيبة جدي، وقبل أن تتزوجه، أقدمت على فعل يعتبر شجاعا دون ريب في إسطنبول عام 1917: فقد ذهبت معه إلى مطعم! لأنهما كانا يجلسان على طاولة مقابل بعضهما، ولأنه تم تقديم المشروبات لهما، أحب أن أتخيل أنهما كانا في مطعم ومقهى في بيرا، كان في ذلك الوقت حي ذا أغلبية مسيحية. عندما سألها جدي ماذا تريد أن تشرب (كان يقصد شاي أو ليمون)، اعتقدت أنه يقترح شيئا أقوى فأجابته بلهجة جافة: “سيكون علي أن أخبرك، سيدي، أنني لا أمس الكحول مطلقا”.
لاحقا وبعد أربعين عاما، إذا حصلت على شيء من البهجة إثر قدح البيرة الذي سمحت به لنفسها على عشاء عائلتنا في ليلة رأس السنة، غالبا ما سيردد أحدهم هذه القصة، وستطلق هي العنان لضحكة عريضة خجلة. لو كان يوما عادياً، وكانت جالسة على مقعدها المعتاد في غرفة الجلوس الخاصة بها، لضحكت لفترة وجيزة وبعد ذلك تذرف بعض الدموع للموت المبكر للرجل “الاستثنائي”، الذي عرفته فقط من مجموعة من الصور الفوتوغرافية. ببكائها، سأحاول تخيلها وجدي يسيران الهوينى عبر شوارع المدينة، لكن من الصعب تخيلها، كأرملة ذات مقام اجتماعي رفيع، ممتلئة الجسد، مسترخية، في لوحة من لوحات رينوار، أو كامرأة نحيفة، طويلة القامة، عصبية، في لوحة لمودلياني.
ستائر التول في غرفة جلوس جدتي كانت مغلقة دائما، لكنها أحدثت بعض الفارق، لأن المبنى المجاور كان قريبا بما يكفي لإبقاء الغرفة مظلمة. لم يكن هناك سطح واحد غير مُغطى بأُطر. احتوى الأكثر فخامة على صورتين ضخمتين علقا فوق المدفأة التي لم تستخدم مطلقا: إحداهما كانت صورة فوتوغرافية لجدتي تم إدخال بعض التحسينات عليها، والأخرى لجدي. من الطريقة التي علقتا بها على الحائط، والوضعية التي اتخذها جدي وجدتي (يلتفتان قليلا تجاه بعضهما البعض، بالطريقة التي لا يزال يفضلها الملوك والملكات الأوروبيين على طوابع البريد)، سيدرك أي شخص التقى بنظرتهم المتعجرفة على الفور أن القصة بدأت معهم.
كان كلاهما من مدينة قرب مانيسا اسمها جورد، في جنوب غرب الأناضول. عُرفت عائلة جدي بباموق (قطن) بسبب بشرتهم الشاحبة وشعرهم الخفيف. أما جدتي فكانت شركسية. (كانت الفتيات الشركسيات شهيرات جدا في الحريم العثماني، وتميزن بطول قامتهن وجمالهن). هاجر والد جدتي إلى الأناضول أثناء الحرب الروسية – العثمانية (1877 – 78)، وفي نهاية الأمر استقر في إسطنبول. كان جدي يدرس الهندسة المدنية هناك. في أوائل الثلاثينيات، عندما كانت الجمهورية التركية الجديدة تستثمر بشكل كبير في إنشاء خطوط السكك الحديدية، جنى جدي قدرا كبيرا من المال، وبعد ذلك أنشأ مصنعا ضخما كان يُصنع كل شيء من الحبال إلى نوع من الخيط المجدول والتبغ الجاف؛ كان المصنع على ضفاف نهر الجوسكو، وهو جدول يصب في البوسفور.
توفي جدي بسبب إصابته بسرطان الدم في 1934، وهو في السادسة والأربعين، وأصبحت جدتي “رئيسة” عائلتنا الكبيرة والثرية. كانت تلك هي الكلمة التي استخدمها طاهيها وصديقها مدى الحياة، بكير، بقليل من السخرية عندما يسأم من أوامرها وشكاواها التي لا تنتهي: “كما تريدين، يا رئيسة!”. لكن سلطة جدتي لم تمتد إلى ما هو أبعد من المنزل، الذي حافظت على أمنه بمجموعة كبيرة من المفاتيح. عندما خسر والدي وعمي المصنع الذي ورثاه عن جدي وهم في سن صغير للغاية، حيث قاما بمشاريع إنشائية مكلفة، واستثمارات متهورة انتهت بالفشل، مما أجبرنا على بيع أصول العائلة واحدا تلو الأخر، ذرفت جدتي مزيد من الدموع وأخبرتهم أن يكونوا أكثر حذرا في المرة القادمة.
نُظمت صور الجيل الجديد بتناسق دقيق على طول الجدران في المكتبة. جعلني تأملي الطويل لها أُقدر أهمية حفظ لحظات بعينها من أجل الأجيال القادمة، كما رأيت مدى التأثير القوي الذي مارسته علينا مسارح الأحداث ونحن نمضي في حياتنا اليومية. بتأمل عمي وهو يطرح مشكلة في الرياضيات على أخي، وفي نفس الوقت رؤيته في صورة التقطت له قبل اثنان وثلاثون عاما؛ وبتأمل والدي يتصفح الجريدة ويحاول، بنصف ابتسامة، الإمساك بذيل دعابة تتموج عبر الغرفة المزدحمة، وفي نفس تلك اللحظة تماما رؤية صورة له وهو في الخامسة من العمر- وشعره طويل كالفتيات- بدا واضحا لي أن جدتي احتفظت بتلك الذكريات حتى نستطيع نسجها مع الحاضر. عندما كانت جدتي تتحدث، وهي تترأس مائدة العشاء، عن جدي الذي توفي في سن صغيرة، بالنبرات التي تحتفظ بها عادة لنقاش تأسيس أمة، مشيرة إلى الصور على الطاولات والجدران، بدا أنها يتجاذبها اتجاهين، أكثر مما ينبغي، فهي ترغب في مواصلة حياتها، لكنها تتوق أيضا إلى اغتنام لحظة الكمال، الاستمتاع بالعادي لكن مع الاحتفاظ بجلال المثالي.
عندما كنت صغيراً، أحببت تلك الوجبات العائلية المرحة. حيث لعبت العائلة لعبة صندوق اليانصيب، وشاهدت أعمامي يضحكون (تحت تأثير الفودكا أو الراكي) وجدتي تبتسم (تحت تأثير قدحها الصغير من البيرة)، لا أستطيع أن اكتب تقريرا موجزا عن كم كانت الحياة ممتعة خارج إطار الصور. لقد شعرت بالأمان للانتماء لعائلة كبيرة وسعيدة، وأن أنعم بخيالية أننا خُلقنا على الأرض لننعم بالسعادة فيها. عندما نكون وحدنا، في خصوصية شقتنا، كانت أمي تشكو دائما لشقيقي ولي من قسوة “عمتك”، و”عمك”، و”جدتك”. في حالة حدوث خلاف على من يمتلك ماذا، أو تقسيم الأنصبة لمصنع الحبال، أومن سيقطن في أي من طوابق المنزل المتعدد الطوابق، كان اليقين الوحيد أنه لن يكون هناك حل أبدا.
رغم أنني كنت يافع جدا على فهم الأسباب الرئيسية لتلك الخلافات، فقد بدأت أتنبه لإفلاس أبي وغياباته المتواترة أكثر من أي وقت مضى، فعائلتي، التي ظلت تعيش كما كانت تفعل أيام القصر العثماني، كانت تتهاوى. كان يمكنني سماع المزيد من التفاصيل عن مدى سوء الوضع كلما اصطحبتنا أمي أنا وأخي لزيارة جدتنا الأخرى في منزلها الذي تمتطيه الأشباح. بينما كنت ألعب أنا وأخي، كانت أمي تشكو وتنصحها أمها بالصبر. ربما شعرت هذه الجدة بالقلق من أن ترغب أمي في العودة إلى المنزل المغبر ذو الثلاثة طوابق الذي تعيش فيه هي الآن وحدها تماما، والذي يعيد إلى أذهاننا سلبياته العديدة.
بصرف النظر عن إظهار العصبية من حين لآخر، لم يجد أبي إلا أسبابا واهنة ليشكو من الحياة؛ لقد حظي بمرح طفولي في نظراته، وذكاء وحظ سعيد، والذي لم يحاول أبدا أن يخفيه. داخل المنزل، كان دائما يطلق صفيرا، يتفحص صورته في المرآة، يمسح بشريحة من الليمون على شعره لتلميعه. أحب أبي الدعابات، وألعاب الكلمات، والمفاجآت، وإلقاء الشعر، والتباهي بمهاراته، واستقلال الطائرات لأماكن بعيدة. لم يكن أبي مطلقا والدا يوبخ أو يمنع أو يعاقب. عندما كان يصطحبنا في نزهة، كنا نتجول في جميع أنحاء المدينة، نكون صداقات أينما ذهبنا، وخلال تلك النزهات بدأت أفكر في العالم على أنه مكان للاستمتاع. إذا ما ظهرت مشكلة، فإن رد فعل أبي يكون بإدارة ظهره لها والبقاء صامتا. أما أمي، التي تضع القواعد، فكانت هي التي ترفع حاجبيها وتعلمنا عن الجانب الأكثر إظلاما من الحياة. لكنني اعتمدت على حبها وحنانها، لأنها منحتنا وقتا أطول بكثير من أبانا، الذي انتهز كل الفرص للهروب من المنزل.
في المساء، عندما كنا نتجمع في غرفة جلوس جدتي كعائلة، كثيرا ما لعبت لعبة تصبح فيه شقة جدتي محطة لقبطان سفينة كبيرة. يدين هذا الخيال بالكثير إلى حركة مرور السفن عبر البوسفور؛ هذه الأبواق الحزينة شقت طريقها في أحلامي وأنا مستلقي في الفراش. بما أنني قدت دفة سفينتي المتخيلة عبر العاصفة، ولن يعاني طاقمي والركاب في المستقبل من الأمواج العالية، فقد شعرت بكبرياء القبطان لمعرفة أن سفينتنا، عائلتنا، قدرنا، كانت بين يدي.
لكن لأن أبي وعمي تعثرا، من إفلاس إلى إفلاس، ولأن ثروتنا تضاءلت وعائلتنا تفككت والخلافات على المال تزايدت، أصبحت كل زيارة لشقة جدتي محنة وخطوة أقرب إلى إدراك، أن سحابة الكآبة والضياع التي تكونت نتيجة انهيار الإمبراطورية العثمانية، التي غيمت سماء إسطنبول، والتي استغرقت وقتا طويلا لتأتي، وجاءت عبر طريق ملتوي، قد قضت أخيرا على عائلتي أيضا.

منزل الباموق
تم بناء منزل الباموق على التلال أعلى المدينة، على حافة قطعة أرض في نيسانتاسي، كانت في يوم ما حديقة قصر أحد الباشاوات. يعود اسم نيسانتاسي (حجر الهدف) إلى أيام السلاطين الإصلاحيين والتغريبيين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، الذين مارسوا الرماية، والقوس والسهم على التلال. عندما ترك السلاطين العثمانيين قصر توب كابي إلى قصور جديدة خارج المدينة القديمة، خوفا من الإصابة بالسُل ورغبة في وسائل الراحة الغربية، وأيضا كتغيير للمنظر، بدأ وزرائهم وأمرائهم في بناء قصور من الخشب على تلال نيسانتاسي.
عبر النوافذ الخلفية لمنزلنا على جادة تيسفيكي، وخلف أشجار السرو والزيزفون، يمكنك رؤية بقايا قصر خير الدين التونسي باشا، شركسي من القوقاز، تقلد منصب الصدر الأعظم لفترة وجيزة بعد الحرب “الروسية – العثمانية” مباشرة. أُحضر وهو صبي صغير، في ثلاثينيات القرن التاسع عشر (قبل أن يكتب فلوبير بعشر سنوات أنه أراد الارتحال إلى إسطنبول وشراء عبد)، إلى إسطنبول تم بيعه ليصبح عبدا، في نهاية المطاف وجد مكانا في بيت والي تونس، حيث نشأ وهو يتحدث العربية، التحق بالجيش، وعمل كمندوب تونسي في فرنسا، وأخيرا عمل في مقرات القيادة، وفي البرلمان، وفي الهيئة الدبلوماسية، وكان رئيسا لمجلس استشاري تم تأسيسه لإصلاح الأحوال المالية للبلاد. بعد أن ترك منصبه استدعاه السلطان لإسطنبول.
عهد السلطان لخير الدين التونسي باشا بمنصب مستشار مالي لفترة قصيرة، وسرعان ما عينه في منصب الصدر الأعظم. وهكذا أصبح الباشا حلقة في سلسلة طويلة من الخبراء الماليين ذوي الخبرة الدولية، والذي مُنح تفويضا لإنقاذ تركيا من الدين. وكما حدث مع العديد من خلفائه، توقع الناس الكثير من هذا الباشا، لمجرد أنه كان ينظر إليه على أنه غربي أكثر منه عثماني أو تركي. ولنفس السبب بالتحديد، غُضب عليه في وقت لاحق. سرت إشاعة أن خير الدين باشا التونسي كان يدون ملاحظات باللغة العربية، وهو في عربته التي تجرها الخيول أثناء عودته لمنزله من اجتماعاته التي كانت تتم باللغة التركية في القصر؛ ثم فيما بعد يقوم بإملائها لسكرتيره بالفرنسية. ثم كانت رصاصة الرحمة، عندما نقل أحد الوشاة شائعة تفيد بأن لغة الباشا التركية رديئة لذا فهدفه السري هو تأسيس ولاية ناطقة بالعربية؛ كان السلطان عبد الحميد يعلم أن تلك الشائعة لا أساس لها، لكنه رغم ذلك عزل الباشا من منصبه. قضى الباشا المطرود بقية حياته في القصر الذي أصبحت حديقته فيما بعد موقع منزلنا المتعدد الطوابق.
القصر الحجري الوحيد الذي لا يزال قائما في منطقتنا كان منزل سابق لصدر أعظم انتقل إلى أيدي المجلس البلدي بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية ونقل العاصمة إلى أنقرة. أتذكر الذهاب من أجل التطعيم ضد الجدري إلى قصر آخر يعود لباشا سابق والذي أصبح المقر الرئيسي للمجلس المحلي. أتذكر الباقي فقط- تلك القصور حيث استضاف فيما مضى المسؤولون العثمانيون المبعوثين الأجانب، وقصور بنات السلطان عبد الحميد- كهياكل مهدمة الآجر ونوافذ منفرجة وأدراج محطمة أظلمها السرخس وشجر التين المهمل. مع أواخر الخمسينيات، أُضرمت النيران في معظمها أو تم هدمها لفتح طريق إلى المباني السكنية.
احتفظت عائلتي برباطة جأش صخرية، وهي تشاهد حرق قصور الباشاوات حتى سويت بالأرض، واحتفظت بنفس درجة رباطة الجأش في مواجهة كل تلك القصص عن الأمراء الحمقى، ومدمني الأفيون في قصر الحريم، والأطفال المحبوسين في العلية، وبنات السلطان الخائنات، والباشاوات الذين تم نفيهم أو اغتيالهم، وأخيرا، إفول الإمبراطورية نفسها. كما رأيناها في نيسانتاسي، تخلصت الجمهورية من الباشاوات، والأمراء، والمسؤولين الكبار، لذا أصبحت القصور الخاوية التي خلفوها ورائهم مجرد أبنية شاذة آيلة للسقوط. ظلت سوداوية وغموض هذه الثقافة المحتضرة حولنا في كل مكان. في الطفولة، شعرت بها كملل مميت، واعتبرتها كالموسيقى التركية القديمة التي كانت جدتي تنقر بخُفها عند سماعها.
كان الخروج مع أمي بمثابة الفرار من المنزل. في ذلك الوقت لم تكن قد أصبحت عادة بعد اصطحاب الأطفال يوميا إلى المتنزهات أو الحدائق من أجل استنشاقهم للهواء النقي، لذا كانت الأيام التي نخرج فيها بالغة الأهمية. “غدا سوف أخرج مع أمي!” سوف أتفاخر أمام ابن عمي الذي يقطن في الطابق الأسفل. بعد هبوط الدرج الحلزوني، ستقف أمي وأنا أمام النافذة الصغيرة التي يستطيع من خلالها المشرف على المنزل رؤية كل من يأتي وكل من يذهب. سوف أتفقد ملابسي في الصورة المنعكسة على النافذة الصغيرة، وستتأكد أمي من أن كل أزراري محكمة؛ ما أن نصبح في الخارج، أهتف بذهول “الشارع”.
شمس، وهواء منعش، وضوء النهار. كان منزلنا مظلم للغاية حتى أصبح الخروج بمثابة فتح للستائر بصورة مفاجئة في يوم صيفي، لقد ألم الضوء عيني. ممسكا بيد أمي، حدقت في المعروضات في واجهات عرض المتاجر: خلال النافذة المشبعة بالبخار لبائعي الزهور، ونبات بخور مريم الذي بدا مثل الذئاب الحمراء؛ في واجهة عرض متجر الأحذية، حيث الأسلاك المرئية بالكاد التي تدلت منها الأحذية عالية الكعب في الهواء؛ في المغسلة (المشبعة بالبخار تماما مثل متاجر باعة الزهور)، حيث الرجال المتصببين عرقا الذين يقومون بتنظيف وكي قمصان أبي.
كانت هناك سيدة يونانية عجوز ترتق الجوارب وتبيع الأحزمة والأزرار؛ وتبيع أيضا “بيض من القرية”، كانت تخرجه من صندوق لامع واحدة بواحدة مثل الجواهر. في متجرها كان يوجد حوض أسماك به سمكة حمراء مموجة ستحاول عض أصبعي، ضاغطة على الزجاج، بتصميم أحمق لم يخفق أبدا في تسليتي. المتجر المجاور، لبيع التبغ والأدوات المكتبية والصحف، وكان صغيرا جدا ومزدحم حتى أن في معظم الأيام كنا نشعر باليأس في اللحظة التي ندخله فيها. وهناك مقهى اسمه “المتجر العربي”. (تماما مثل العرب في أمريكا اللاتينية الذين كانوا معروفين غالبا “بالأتراك”، القلة من ذوي البشرة السمراء في إسطنبول كانوا معروفين “بالعرب”).
تبدأ مطحنة محال القهوة ذات السير الضخم في الهدير مثل غسالة الملابس في المنزل، وعندما أتحرك مبتعدا عنها، يبتسم “العربي” على نحو متسامح تجاه خوفي. عندما تغلق تلك المتاجر، واحدا تلو الآخر، تفسح المجال لسلسلة من المغامرات، قد ألعب أنا وأخي لعبة رغبة في اختبار ذكرياتنا وبدرجة أقل بوحي من الحنين إلى الماضي. سيقول أحدنا، “المتجر المجاور لمدرسة الفتيات الليلية”، والآخر سوف يعدد آخر أمثلة له: (1) متجر معجنات السيدة اليونانية، (2) متجر بيع الزهور، (3) متجر حقائب اليد، (4) متجر الساعات، (5) متجر وكيل مراهنات كرة القدم، (6) متجر بيع الكتب، (7) صيدلية. لكن عبر نوافذ متجر الأدوات المكتبية، الذي لاحظت فيه نفس دفاتر المدرسة التي استخدمها أخي، كنت قد تعلمت درسا في وقت مبكر: أن عاداتنا ومقتنياتنا لم تكن فريدة. فهناك أناس آخرون خارج منزلنا عاشوا حيوات شديدة الشبه بحياتنا.
كثيرا ما ذهب أبي إلى أماكن بعيدة. لم نكن نراه لشهور متواصلة. الغريب، أننا بالكاد كنا نلاحظ غيابه بعد أن يكون قد ذهب بالفعل منذ فترة. في ذلك الحين، كنا قد اعتدنا بالفعل على ذلك- إلى حد ما بالطريقة التي نادرا ما تدرك بها متأخرا- اكتشاف فقدان أو سرقة دراجة مستعملة. لم يفسر لنا احد أبدا السبب وراء عدم وجود أبي معنا، ولم يخبرنا أحد أيضا متى نتوقع عودته. لم يخطر ببالنا الضغط من أجل الحصول على معلومة، لأننا كنا نعيش في منزل كبير مكون من عدة طوابق، محاط بأعمام، وعمات، وجدتي، وطهاة، ووصيفات، كان من السهل المرور بخفة على غيابه دون التوقف عن التساؤل عن أسبابه.
عندما يلوح الضجر، انحي الزجاجات والُفرش تجاه منتصف منضدة زينة أمي، بالقرب من صندوق فضي مغلق مزخرف بالأزهار لم أرى أمي تفتحه أبدا ولو لمرة واحدة، وأوجه رأسي إلى الأمام حتى أستطيع رؤيتها في اللوح الأوسط للمرأة ثلاثية الألواح، ثم أدفع جناحا المرآة للداخل أو للخارج حتى أرى الآلاف من وميض أورهان في عمق لانهائية الزجاج الملون البارد. عندما نظرت في داخل أقرب الانعكاسات، تصدمني مؤخرة رأسي، كما فعلت أذناي أولا- لقد أصبحا عند نقطة دائرية في الخلف، وبرزت إحداها أكثر من الأخرى، تماما مثل أذنا أبي. كانت مؤخرة عنقي أكثر إثارة، جعلتني أشعر وكأن جسدي شخص غريب حملته معي- الفكرة لا زالت مرعبة. الحصار بين ثلاثة مرايا، والعشرات والمئات من انعكاسات أورهان التي تتغير كلما عدلت أوضاع اللوح ولو قليلا، وبرغم أن كل تتابع جديد كان مختلفا عن كل الآخرين، كنت فخورا برؤية مدى زيف كل انعكاسه حاكت كل إيماءة.

أصبح ذوباني داخل انعكاساتي “لعبة الاختفاء”، وربما لعبتها من أجل إعداد نفسي للأمر الذي كنت أرهبه إلى أبعد حد، على الرغم من أنني لم أعرف ما كانت تقوله أمي على الهاتف، أو أين كان أبي ومتى سيعود، عرفت أن أمي كانت عرضة للاختفاء أيضا. لكن عندما اختفت أعطونا سببا: من قبيل “والدتك مريضة وتستريح عند خالتك ناريمان”.
تعاملت مع تلك التفسيرات مثلما تعاملت مع انعكاسات المرآة: بمعرفة أنها أوهام، ظللت أقبلها، سامحا لنفسي بأن أُخدع. قد تمر بضعة أيام قبل أن يتم تسليمنا لبكير الطاهي أو إسماعيل مشرف المنزل. سوف نستقل معهم قوارب وحافلات على طول الطريق عبر إسطنبول- إلى أقارب على الجانب الآسيوي للمدينة، في إرنكوي، أو إلى أقارب آخرين في مدينة أستينيا على مضيق البوسفور- لزيارة أمي. لم تكن تلك الزيارات محزنة: لقد كانت كالمغامرات. لأن أخي الأكبر كان معي، شعرت أن بإمكاني الاعتماد عليه في مواجهة كل المخاطر.
كل المنازل التي زرناها كانت مأهولة بأقارب ذوي صلة قريبة أو بعيدة لأمي. عندما تنتهي الخالات العجائز الحنونات والأخوال غزيري الشعر من تقبيلنا وقرص وجناتنا، يشرعون في عرض أي شيء قد يكون غريبا لديهم في منزلهم من شأنه جذب انتباهنا- اعتقدت ذات مرة أن مقياس الضغط الجوي، الألماني الصنع، تتشاركه كل منازل المدينة المُستغربة (نموذج مصغر لرجل وزوجته بملابس بافارية يغادران ويعودان لمنزلهما وفقا لحالة الطقس)؛ أو ساعة حائط بطائر وقواق يدور حول محورها ويعود بسرعة إلى قفصه كل نصف ساعة ليعلن عن الوقت؛ أو عصفور الكناري الحقيقي الذي يغرد ردا على ابن عمة الآلي- ثم نمضي إلى غرفة أمنا.
انبهارا بالامتداد الساحر للبحر الذي يظهر عبر النافذة، وجمال الضوء (ربما لهذا السبب أحببت دائما مشاهد النافذة المواجهة للجنوب لماتيس)، سوف نتذكر، بحزن، أن أمنا قد تركتنا إلى هذا المكان الغريب والجميل، لكننا اطمأننا من الأغراض المألوفة التي رأيناها على منضدة الزينة الخاصة بها، نفس الملاقيط وزجاجات العطر، ونفس فرشاة الشعر بظهرها المصقول المقشور نصفه، ورائحتها العطرة التي لا تضاهى وهي تنبعث عبر الهواء.
أتذكر كيف كانت تأخذ كل واحد منا، بالدور، على حجرها، وتحتضنا بدفء، كيف كانت تعطي أخي تعليمات مفصلة عما يجب أن يقول، وأن يتصرف، وأين يجد الأغراض التي يجب عليه إحضارها لها عندما نأتي في المرة القادمة. كانت أمي مولعة دائما بتوجيه التعليمات. بينما كانت تقوم بكل هذا، كنت أنظر من النافذة، لا أعيرهم أي انتباه حتى يحين دوري في الجلوس على حجرها.
ذات يوم، كانت أمي مقيمة عند خالتي ناريمان، عاد أبي إلى المنزل ومعه مربية. كانت قصيرة، ذات بشرة شاحبة تماما، أبعد ما تكون عن الجمال، ممتلئة الجسم، ومبتسمة دائما؛ عندما تسلمت مسئوليتنا قالت أننا يجب أن نتصرف كما تفعل هي تماما. المربيات اللائي عرفناهم كن في الأغلب ألمانيات، بأرواح بروتستانتية؛ هذه المربية كانت تركية ولم يكن لديها سلطة علينا.
عندما كنا نتشاجر كانت تقول، “بلطف وهدوء، من فضلكم، بلطف وهدوء”، عندما قلدناها أمام أبي ضحك. لكن بعد فترة وجيزة اختفت هي أيضا. وبعد عدة سنوات، وعندما كانت أمي تفقد أعصابها كانت تتفوه بكلمات من قبيل “سأرحل!” أو “سألقي بنفسي من النافذة!” (ذات مرة مضت إلى حد بعيد بتدلية إحدى ساقيها الجميلتين من عتبة النافذة). لكن عندما كانت تقول، “ومن ثم، سيتزوج والدك تلك المرأة الأخرى!”، لم أكن أتخيل المرأة المرشحة كي تكون الأم الجديدة واحدة من السيدات اللائي كانت أمي أحيانا تفشي أسمائهن دون تفكير في لحظة غضب، بل تلك الشاحبة، الممتلئة الجسد، حسنة النية، والمربية المرتبكة.
لأن كل تلك الأحداث وقعت على نفس المسرح الصغير، ولأننا تقريبا تحدثنا دائما عن نفس الأمور، وتناولنا نفس الطعام، كانت الخلافات مملة إلى أقصى حد. لكن هناك شجار حدث في السنوات الأولى كان له أثر أعمق علي. ذات مساء، أثناء تناولنا العشاء في منزلنا الصيفي على جزيرة هيبلي، غير بعيدة عن إسطنبول، غادر كلا من أبي وأمي المائدة. لبعض الوقت، جلست أنا وأخي نحدق في أطباقنا ونحن ننصت لهما وهما يصيحان في بعضهما البعض في الطابق الأعلى، بعد ذلك، وبما يشبه الغريزة، صعدنا إلى الطابق الأعلى.
عندما رأتنا أمي نحاول الانضمام للشجار، دفعت بنا إلى داخل الغرفة المجاورة وأغلقت الباب. كانت الغرفة مظلمة، لكن سطع ضوء قوي عبر تصميمات الفن الحديث التي كانت على الزجاج البلوري للبابين الفرنسيين الكبيرين. راقبت أنا وأخي ظلا أمنا وأبانا وهما يقتربا من بعضهما ثم يبتعدا، ثم يتحركا للإمام مرة أخرى ليتلامسا، كانا يصيحان وكأنهما اندمجا في ظل واحد. من وقت لآخر، أصبحت لعبة الظل هذه عنيفة جدا لدرجة اهتزاز الزجاج البلوري، مثلما حدث تماما عندما ذهبنا إلى مسرح خيال ظل كراكوز (شخصية شهيرة في مسرح خيال الظل التركي.م) وكان كل شيء أسود وأبيض.
أمضت جدتي أصباحها في الفراش، تحت لحاف ثقيل، متكئة على كومة وسائد ضخمة من الريش. كل صباح، يقدم لها بكير بيض برشت، وزيتون، وجبن ماعز، وخبز محمص على صينية يضعها بحرص على وسادة (كان يمكن أن يفسد الأجواء لو وضعت صحيفة قديمة بين الوسادة المطرزة بالأزهار والصينية الفضية، كما تملي الناحية العملية)؛ تتريث جدتي في تناول إفطارها، تقرأ الصحيفة وتستقبل أول زوار اليوم. (تعلمت منها بهجة احتساء الشاي الحلو مع قطعة من جبن الماعز الصلبة في فمي).
لم يكن عمي يذهب إلى عمله مطلقا دون أن يعانق أمه أولا، وكان يقوم بزيارته مبكرا كل صباح. بعد أن تودعه عمتي، تعرج هي أيضا، ممسكة حقيبة يدها. لفترة قصيرة قبل بداية المدرسة، عندما تقرر أنه حان الوقت لتعلم القراءة، قمت بما كان يقوم به أخي: فكل صباح، كنت أصل ومعي دفتر في يدي، وأوطد نفسي على لحاف جدتي، محاولا تعلم الحروف الأبجدية منها. سوف أكتشف عندما أبدأ المدرسة، شعوري بالسأم من تعلم أشياء من شخص آخر، وعندما كنت أرى ورقة بيضاء لم يكن أول دافع لدي كتابة شيء ما، بل تلطيخ الصفحة برسومات.
في وسط دروس القراءة والكتابة تلك، يدخل بكير ويسأل نفس السؤال، مستخدما نفس الكلمات: “ماذا سنقدم لأولئك الناس اليوم؟”.
سأل بكير هذا السؤال بجدية كبيرة، وكأنه كان مسؤولا عن إدارة مطبخ مستشفى كبير أو ثكنة عسكرية. يتناقش بكير وجدتي حول من سيأتي من أي شقة على الغداء والعشاء، وما يجب طهيه لهم، بعدئذ تخرج جدتي روزنامتها الضخمة، المليئة بالمعلومات الغامضة وصور لساعات حائط؛ بدوا وكأنهم يبحثون عن أفكار ملهمة “لقائمة طعام اليوم”، بينما كنت أراقب غراب يطير بين أغصان شجرة السرو في الحديقة الخلفية.
على الرغم من ثقل عبء العمل، فإن بكير لم يفقد أبدا حسه الفكاهي وكانت لديه أسماء يكني بها كل من في الأسرة، من جدتي إلى أصغر أحفادها. كان لقبي الغراب. بعد سنوات، أخبرني أن ذلك اللقب كان بسبب أنني كنت دائما أراقب الغربان على السطح المجاور، وأيضا لأنني كنت نحيفا. كان أخي متعلق جدا بدمية الدب خاصته ولم يكن يذهب إلى أي مكان دونها، لذا بالنسبة لبكير كان يلقبه بالممرض. أحد أبناء عمومتي كان لقبه اليابان، لأنه كان ذا أعين ضيقة؛ ابن عم آخر، لأنه كان عنيدا، لقبه بالعنزة. وآخر، لأنه ولد مبتسراً لقبه بستة أشهر. ظل بكير لسنوات يدعونا بتلك الأسماء، بسخريته اللطيفة المخففة بالحنو.
في غرفة جدتي، كما في غرفة أمي، توجد منضدة زينة بمرآة ذات أجنحة؛ كنت أحب فتح لوحاها والذوبان في الانعكاسات، لكن هذه المرآة لم يكن مسموحا لي بلمسها. وضعت جدتي، التي لم تتزين مطلقا، المنضدة بطريقة تمكنها من رؤية كل المتسع أسفل الممر الطويل، مرورا بمدخل الخدمات والردهة، وعبر غرفة الجلوس مباشرة إلى النوافذ المطلة على الشارع، مما يسمح لها بمراقبة كل ما يحدث في المنزل- القادمين والذاهبين، الأحاديث في الأركان، ومشاجرات الأحفاد في الجانب الآخر- دون مغادرة الفراش. لأن المنزل حالك الظلام على الدوام، كان انعكاس أحداث معينة ضعيفا جدا بما لا يسمح برؤيتها، لذا وجب على جدتي الصياح بصوت عالِ للسؤال عما يحدث، فيسارع بكير بتقديم تقرير عن من يفعل ماذا.
عندما لم تكن تقرأ الجريدة أو تطرز زهورا على أغطية الوسائد، أمضت جدتي أوقات الظهيرة مع سيدات أخريات من نيسانتاسي، أغلبهن من نفس عمرها، يدخن السجائر ويلعبن البيزيك (لعبة من ألعاب الورق.م)، وأيضا البوكر في بعض المناسبات. بين أفيشات البوكر، التي احتفظت بها في جراب أملس مخملي قانِ، كانت توجد عملات معدنية عثمانية مثقوبة، بعضها ذات حواف صدفية وأخرى نُقشت عليها علامات إمبراطورية، كنت أحب أن آخذها إلى إحدى الأركان وألعب بها.
كانت إحدى السيدات على طاولة اللعب من حريم السلطان؛ وبعد سقوط الإمبراطورية، عندما أُجبر العثمانيين على مغادرة إسطنبول، أغلقوا الحريم، وتزوجت هذه السيدة من أحد زملاء جدي. سخرت أنا وأخي من أسلوبها المهذب المبالغ فيه في الحديث: فبالرغم من حقيقة أنها وجدتي كانتا صديقتان، فإنهما كانتا تخاطبان بعضهما البعض “بمدام” بينما ينهالون بسعادة على اللفائف الهلالية المشبعة بالزيت والجبن المحمص التي يحضرها لهن بكير من الفرن مباشرة.
كلتاهما كانت بدينة، لكن لأنهما عاشتا في عصر وثقافة لم تكن فيه البدانة وصمة، كانتا تشعرا بالراحة حيال ذلك. لو وجب على جدتي الخروج- كما قد يحدث مرة كل أربعين عاما- فإن الاستعدادات قد تستمر لعدة أيام، إلى أن تنادي جدتي بأعلى صوتها على قمر هانم، زوجة الحاجب، كي تصعد وتسحب بكل قوتها خيوط مشدها. كنت أشاهد بتوتر تطور مشهد المشد من خلف الستار مع الكثير من الدفع والسحب، والصياح “بهدوء يا فتاة بهدوء!”. فُتنت أيضا من مدرمة الأظافر، التي قدمت في زيارة لجدتي منذ عدة أيام. جلست هذه المرأة هناك لساعات، مع أوعية عميقة بها ماء وصابون، وعديد من الأدوات الغريبة تجمعت كلها حولها؛ وقفت متسمرا وهي تطلي أظافر قدم جدتي الموقرة بلون أحمر يشبه لون سيارات الإطفاء، ومشهدها وهي تضع كريات القطن بين أصابع جدتي الممتلئة، أثار في نفسي مزيج من الافتنان والاشمئزاز.
بعد عشرين عاما، عندما كنا نعيش في منازل أخرى في مناطق أخرى من إسطنبول، كثيرا ما زرت جدتي في منزل الباموق، إذا ما وصلت في الصباح أجدها في نفس الفراش، محاطة بنفس الحقائب، والصحف، والوسائد، والعتمة. لم تتغير رائحة الغرفة أيضا، كانت مزيج من الصابون، والكولونيا، والرماد، والخشب.
احتفظت جدتي معها دائما بدفتر جلدي صغير الحجم مربوط، سجلت فيه كل يوم الفواتير والمذكرات والوجبات والمصروفات وجداول المواعيد وتطورات الأحوال الجوية. ربما لأنها درست التاريخ، كانت تحب إتباع “قواعد سلوك رسمية” في المناسبات- ورغم ذلك كانت توجد دائما نغمة سخرية في صوتها عندما تفعل ذلك- وكل حفيد من أحفادها الخمسة سمي على اسم سلطان منتصر.
كل مرة أراها فيها، كنت أُقبل يدها؛ بعدئذ تعطيني بعض النقود، التي كنت بخجل لكن بسرور أدسها في جيبي. بعد أن أحكي لها أخبار أمي وأبي وأخي، كانت أحيانا تقرأ لي ما كتبته في دفترها: “أتى حفيدي أورهان في زيارة. إنه ذكي جدا، ولطيف جدا. هو يدرس الهندسة المعمارية في الجامعة. لقد أعطيته عشرة ليرات. بمشيئة الله، سيصبح يوما ما ناجحا جدا، وسيكون الحديث عن عائلة باموق بكل احترام مرة أخرى، كما كان عندما كان جده حيا”.
بعد قراءة هذا، كانت تنعم لي النظر عبر نظارتها، التي تجعل من إعتام عدسة عينها يبدو أكثر إرباكا، وتمنحني ابتسامة غريبة ساخرة.
بينما كنت أتسائل ما إذا كانت تضحك من نفسها أو تضحك لأنها عرفت الآن أن الحياة كانت محض هُراء، حاولت أن ابتسم لها بنفس الطريقة.
من هو أورهان باموق؟
أورهان باموق كاتب وروائي تركي فاز بجائزة نوبل في الآداب عام 2006، ولد في إسطنبول عام 1952، ينتمي إلى أسرة تركية مثقفة، درس العمارة والصحافة قبل أن يتجه إلي الأدب والكتابة، يُعد أحد أهم الكتاب المعاصرين في تركيا، ترجمت أعماله إلى 34 لغة.
وفي فبراير 2003 صرح باموق لمجلة سويسرية بأن “مليون أرمني و30 ألف كردي قتلوا على هذه الأرض، لكن لا أحد غيري يجرؤ على قول ذلك”. تمت ملاحقته قضائيا أمام القضاء التركي بسبب “الإهانة الواضحة للأمة التركية”، ولشخصية شبه مقدسة عند الأتراك وهي شخصية (مصطفى كمال أتاتورك) وهما جريمتين يعاقب عليهما القانون وقد عفي من الملاحقة القضائية أخيرا في نهاية 2006.
بجانب تصريحاته حول “مذابح” الأرمن والأكراد، كان باموق أول كاتب ينتمي للعالم الإسلامي يدين الفتوى الإيرانية التي تبيح دم الكاتب سلمان رشدي. في فبراير 2007 وبعد مقتل أحد الصحفيين الأتراك من أصل أرمني لكتاباته التي تندد بمذابح الأرمن، تلقى أورهان باموق تهديدات بالقتل، وأكدت السلطات الأمنية جدية هذه التهديدات، فسافر هاربا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
أعمال أورهان باموق
من أعماله، جودت بيه وأبناؤه (رواية) صدرت عام 1982، المنزل الهادئ (رواية) صدرت عام 1991، القلعة البيضاء (رواية) صدرت عام 1995، الكتاب الأسود (رواية) صدرت عام 1997، ورد في دمشق (رواية) صدرت عام 2000، الحياة الجديدة (رواية) صدرت عام 2001، اسمي أحمر (رواية) صدرت عام 2003، ثلج (رواية) صدرت عام 2004، وله كتاب واحد عن حياته، إسطنبول (رواية) صدر عام 2003. متحف البراءة (رواية) صدرت عام (2008)، غرابة في عقلي (رواية) صدرت عام (2014).
ترجمتها من التركية، مورين فريلي Maureen Freely.
ترجمها للعربية: وليد سامي
النيويوركر عدد 7 مارس 2005
بقلم/ أورهان باموق