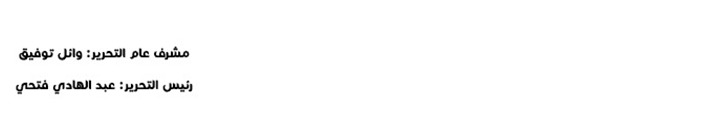كلمة سر نجاح فيلم فوي فوي فوي
كتب: د. سمير مندي
فيلم فوي فوي فوي.. زادت أسهم فيلم «فوي فوي فوي» في بورصة العروض السينمائية بعد ترشيحه للمنافسة على جوائز الأوسكار. وزاد مع هذه الأسهم رصيد السينما المصرية ببطولة الفنان الشاب محمد فرّاج للفيلم. فهو ممثل يتمتع بِطَلّة خاصة، وحضور مميز على الشاشة الكبيرة. سواء بملامحه المصرية العادية التي تراها في أقرب وجه رجل قد يصادفك في الشارع أو في المقهى. فلا هو سوبرمان يغزو السينما بعضلاته، ولا هو من هؤلاء الذين احترفوا تمثيل دور الأبْلَه كي ينتزعوا ضحكًا مجانيًا من الجمهور، ويحصدوا أرقامًا هائلة في شباك التذاكر والسلام. خصوصًا وأن قصة الفيلم ليست من طراز «أغنية وضحكتين وكلمتين حب».
فهي قصة تطرح مشكلة حقيقية، وتُطلق صرخة ألم مدوية ضد أوضاع مُزرية يعيشها المجتمع المصري. وذلك بخلاف ما اعتدنا عليه من حبكات سينمائية تمر بخفة فوق مشكلاتنا. ما لم نقل إنها تُسفه من هذه المشكلات، وتقلل من أهميتها. فوق هذا وذاك، فإن الفيلم هو التجربة الأولى في إخراج الأفلام الطويلة للمخرج عمر هلال الذي كتب قصته أيضًا. فكيف يمكن أن نُقيّم هذه التجربة؟ وهل استطاع عمر هلال أن يكتب صفحة جديدة جادة في تاريخ السينما المصرية؟
قصة فيلم فوي فوي فوي
الحكاية حكاية الشاب «حسن»، يلعب دوره محمد فرَّاج، الذي يعمل فرد أمن في جراج ويلعن الظروف التي حكمت عليه بالفقر، وأجهضت أحلامه في الحب والزواج. وحكاية صديقيه اللذين يعانيان أيضًا نفس ظروفه، وينتظران، على أحر من الجمر، أول فرصة للقفز من مركب الفقر. والفرصة التي لا بديل لها هي فرصة الهجرة إلى أوروبا، أو الهرب إليها مهما كان الثمن.
لكن لا «حسن» ولا صديقيه يستطيعون أن يدفعوا ثمن المغامرة على مركب في عرض البحر، قد يعودون منها جثثًا هامدة ترقد في توابيت. فجأة تلمع فكرة، لم تكن على البال ولا الخاطر. بالصدفة يقرأ «حسن»، في نفس ورقة الجريدة التي لُف فيها إفطاره، خبرًا عن نادي للعب كرة القدم للمكفوفين. يدرب النادي لاعبيه المكفوفين من أجل خوض بطولات في إفريقيا وأوروبا. سرعان ما يمثل «حسن» دور مكفوف طموح يريد أن ينضم للفريق، ويلعب بين صفوفه. يرحب نادي «الإحسان» بالمتدرب الجديد ويضمه بين صفوفه.
ومع أنَّ الكابتن عادل، كابتن الفريق، يلعب دوره بيومي فؤاد، يكتشف خدعة «حسن» إلا أنه يَغض الطرف عنها، لاسيما بعد أن فاز الفريق، بفضل حسن، في البطولة الإفريقية بتغلبه على الفريق الكيني على أرضه. يصبح الفريق المصري مؤهلاً، بهذا الفوز، لخوض بطولة أوروبا التي ستقام في بولندا. خطوة جعلت «حسن» قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمه في الفرار إلى أوروبا. وما إن يصل الفريق إلى بولندا حتى نكتشف أن فريق كرة القدم للمكفوفين كله لم يكن فريقًا من المكفوفين، إنما فريق من الحالمين بالهجرة تظاهروا بالعمى، مثلهم في ذلك مثل «حسن»، من أجل الفرار إلى أوروبا.
فوي فوي فوي أو أنا قادم
سوف يعرف المشاهد خلال فرجته على الفيلم أن «فوي فوي فوي» عبارة إسبانية تعني «أنا قادم» يصرخ بها اللاعبون المكفوفون خلال لعبهم. لكن «فوي» سرعان ما تتحول، بتتابع الأحداث، إلى صرخة كل عاجز في مواجهة عجزه، ووعد يتعهد به أمام نفسه ورغم أنف ظروفه على تحقيق حلمه، وإن يكن الحلم حلم هجرة غير شرعية. وإن تكن الوسيلة هي الاحتيال والسرقة والشروع في التخلص ممن قد يكون عقبة في سبيل تحقيق هذا الحلم.
لعبة العمى
إن الفيلم وإن نجح في نصفه الأول في نقل صورة لواقعنا الصعب بعد ثورة 25 يناير مباشرة، إلا أنه قفز في نصفه الثاني على كل قاعدة وكل قانون في سبيل أن يصل بالمتفرج إلى نهاية سعيدة أو مٌرضية. فقد وَضعنا الفيلم، وجهًا لوجه، أمام مشكلات مادية واجتماعية يعاني منها المجتمع المصري.
ولم تكن مشكلة ضعف الانتماء الوطني أو انخفاض درجة حرارته خارج حسبة هذه المشكلات. يقولها «حسن» بحُرقة للصحفية إنجي، تلعب دورها نيللي كريم، عندما تحاول أن تثنيه عن فكرة الهجرة، بعد أن وقعت في حبه: «أنا عشت عمري كله علشان أمشي من هنا أصلاً». ثم يقول بعدها: «خدت إيه أنا علشان أديه؟ خدت إيه؟!»، فأن تكون الحياة رهن بالرحيل، وأن تفقد، في سبيل هذا الهدف، مبررات العطاء فلا تسأل عن انتماء ولا يحزنون. ولا تسأل حتى عن أم عجوز وحبيبة انتظرت سنوات تركهما «حسن»، ببساطة، وراءه.
لكن التسويات التي يقوم بها حسن وصديقيه من أجل الهرب إلى أوروبا تضع مصداقية الفيلم على المحك. فهي تسويات تعود وتفعل ما تفعله معظم الأفلام المصرية من غض الطرف عن قوانين الواقع واحتمالاته. فإذا كنا نتفهم أحلام حسن وصديقيه في الهجرة إلى أوروبا، والفرار من واقعهم الصعب، فإننا لا نتفهم الجرائم التي ارتكبوها في سبيل تحقيق هذا الحلم. ولا نتفهم، بالمثل، الاستسهال الذي يفلت به حسن وصديقيه من قبضة القانون بعد كل ما فعلوه.
فكيف أمكن، مثلاً، أن يخدع «حسن» منتخب «كينيا» لكرة القدم للمكفوفين، بعماه، على حين لم تصمد خدعته طويلاً أمام بديهة مدربه وزملائه؟ وكيف أمكن أن يرتكب جريمة سرقة وشروع في قتل ثم أفلت ببساطة من الوقوع في قبضة الشرطة؟ بل كيف أمكن أن يهرب أعضاء الفريق جريًا على الأقدام من الشرطة البولندية دون أن تتمكن من اللحاق بهم، وكأنها لعبة عسكر وحرامية؟!
هذا التبسيط المخل للأحداث قد يفسر غَلبة الكوميديا على النصف الثاني من الفيلم. إذ يتحول الضحك إلى غطاء يُداري به المخرج ضعف المعالجة الدرامية. فكأن المخرج يرشو المتفرج بالضحك ليتظاهر بالعمى أمام ما يبدو غير واقعي أو غير معقول. بالضبط مثل لعبة التظاهر بالعمى التي يلعبها أبطال الفيلم.
كلمة سر نجاح الفيلم
سواء اخترنا أن نبكي أو أن نضحك مع الفيلم، فإن الرسالة المنشودة تصل إلى المتفرج بوضوح. رسالة حول واقع لا نمتلك إزاءه إلا أن نبكي أو أن نضحك. ورد الفعل في كلتا الحالتين لا يدل إلا على فداحة هذا الواقع وصعوبته. وبقدر ما مضى الفيلم في أكثر من اتجاه بقدر ما كشف عن الأداء المتميز لمحمد فرّاج الذي استطاع أن ينقل إلينا، في بساطة وعمق، حالة اليأس الممزوج بالمرارة التي يحيّاها حسن، ويحيّاها، ربما، كل شاب مصري. هذه الحالة التي تستهين بأي شيء، وكل شيء في لحظة معينة من لحظات معاناتها.
أيضًا الأداء المتميز للممثل طه دسوقي، في دور قدرة، والممثل بسام الحجار اللذين نقلا إلينا إحساسًا صادقًا بالعفوية والطيبة التي نلمسها في الشخصية المصرية حتى في لحظات الشر. أما دور الصحفية الذي لعبته نيللي كريم فقد عكس النضج الذي وصلت إليه فنانة مثلها تمثل وكأنها لا تمثل. أيضًا وُفق المخرج في اختيار مواقع التصوير. فبفضل واقعية هذه المواقع اندمج وعينا في الوضع المادي والاجتماعي البائس الذي يحياه الأبطال واقتربنا منهم، وصدّقنا أنهم يعيشون حياتنا، مثلما صدّقنا أنهم يعانون معاناتنا.
فكلمة سر الفيلم، وسر نجاحه هي حياتنا التي نراها فيه فنبكي عليها، أو نضحك منها.